الفصل الثالث من كتاب بيت حانون تاريخ وحضارة للمؤلف م.محمود الزعانين
الفصل الثالث
الحياة الاقتصادية
من المعروف إن الحياة الاقتصادية للقرى الفلسطينية كانت صعبة وقاسية ، حيث إن معظم سكانها يعتمدون على زراعة الأرض لكسب قوتهم والتي كانت تمثل مصدر الرزق الوحيد ، وكان أهالي البلدة فلاحين يزرعون الأرض بالوسائل القديمة وكانت تساعدهم الأبقار والحيوانات التي تستخدم في حرث الأرض .
الزراعة:
يحتاج العمل الزراعي إلى مجهود كبير يشارك فيه كل أفراد الأسرة ، والمحاصيل تحتاج إلى زراعة وجمع ونقل ودرس إذا كانت حبوبا ، ولقد كان للأمطار دور هام في مدى نجاح المحاصيل الزراعية ، حيث إنها تعتمد على معدل سقوط الأمطار خلال العام ، ولقد ساعدت تربة بيت حانون السكان على الزراعة وذلك لأنها تحتفظ بالماء لفترات طويلة ، وقد اعتمد السكان على نوعين من الزراعة :
-1 الزراعة البعلية: وكانت تزرع في الأراضي التي لا تتوفر فيها المياه ، كأشجار الزيتون والتين و اللوز والتفاح والمشمش والخوخ ، و كذلك الحبوب كالقمح والشعير وغيرها ، وكان السكان يعمدون إلى تنويع المحاصيل في كل سنة لما له من أثر طيب في خصوبة التربة.
وتحتاج كل زراعة إلى طريقة خاصة فزراعة الذرة والسمسم تختلف عن زراعة الحبوب ، حيث إن زراعة الذرة لها طريقة خاصة وفيها يتم تركيب مأسورة مجوفة من الداخل وفي فتحتها محقن على السكة التي تجرها الحيوانات ، و يقوم الفلاح بتنقيط الحبوب الخاصة لزراعة الذرة أو السمسم في محقان المأسورة حتى تنزل خلف مجرى الحسيم ، وتتوارى بواسطة الجر .
أما زراعة الحبوب يتم بذرها على الأرض ويتم حرث الأرض مباشرة قبل أن تقوم الطيور بأكل الحبوب.
أما في العصر الحديث ومنذ ستينات القرن الماضي ، تطورت أدوات الزراعة فأصبحت الأراضي تحرث بواسطة سكة حديد خاصة تجر بواسطة التراكتور الزراعي تنزل إلى عمق التربة وتقلبها وكذلك فرامة الأرض وغيرها ، وأصبحت الزراعة بشكل أفضل وتطور الإنتاج الزراعي وقل الاعتماد على الأيدي العاملة .
البذور المستخدمة في الزراعة:-
كان الفلاح يقوم بانتقاء البذور ويهتم بالجودة وذلك حتى يكون الإنتاج خصباً ، وقد كان يحافظ على البذور حتى يأتي موعد البذر، وكانت البذور تنقع قبل زراعتها ، ولقد كانت الذرة تنقع في محلول الجنزارة حفاظاً عليها من الآفات ، أما حبوب الخضار مثل البندورة والخيار والبطيخ والبامية والكوسا والفقوس وغيرها من الخضراوات ، كانت تنقع في الماء قبل زراعتها أو يتم زرعها في أحواض ويتم نقلها بعد أن تصبح أشتالاً صغيرة ، ولقد كانت جميع أنواع الحبوب والخضروات تزرع في بيت حانون الصيفية والشتوية ، فقد كانت مصدر الدخل الوحيد للسكان وتشكل المساحة التي يستخدمها السكان للزراعة حوالي 70% من إجمالي مساحة البلدة .
وبعد ذلك أصبح التركيز على زراعة الحبوب وخاصة القمح والذي كانت تزرع به معظم أراضي بيت حانون في النصف الأول من القرن الماضي لأنه الغذاء الرئيسي للإنسان والحيوان ، فعيدان ورق القمح (التبن و القصل ) تستخدم كغذاء للحيوانات وكذلك كان يستخدم في بناء المنازل القديمة (البوايك) والتي تبنى من الطين .
وتتنوع الحبوب إلى عدة أنواع ومنها:-
القمح:- ومن الأنواع التي كانت تزرع في البلدة
الدبية: سنبلته طويلة ومنتفخة ولها سفير أسود وحبوبها دبية وكبيرة وممتلئة وهي من الأصناف الجيدة .
الحرباوي: حبة رفيعة لونها قاتم نسبياً.
السمرة: حبة ذهبية لونها زاهي .
النورس: من الأنواع الجيدة وبدأت زراعته في فلسطين بعد العام 1940ميلادي.
استرالي: حبته ممتلئة، ويكون خبزها أبيض وبدأ زراعتها في فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية.
الشعير:- ويتكون من نوعين
شعير سنبلة بصفين من الحبوب، وهو غير مرغوب لدى الفلاح.
شعير سنبلة بسبعة صفوف من الحبوب .
العدس:-
ومن أجود أنواعه المزروع في الأراضي الفلسطينية، ويتم إنتاجه حسب الحاجة للاستهلاك.
حصاد المحاصيل ودرسها:-
كان الحصاد يتم بالطريقة اليدوية باستخدام المنجل ( وهو عبارة عن سكين معقوف على شكل هلال) ويشترك في عملية الحصاد النساء والأولاد والرجال ، حيث يتم جمعه في مكان محدد و كان ينقل بواسطة الدواب كالحمير و الجمال إلى الجرن (وهو المكان الذي كانت توضع فيه المحاصيل بعد حصادها ، وكان يستخدمه كل أبناء البلدة ويوجد أمام المنازل القديمة لمسطح البلدة شرق المقبرة ، وتبلغ مساحته حوالي 20 دونماً وتحول بعد ذلك إلى ملعب للكرة ومن ثم أقيم مكانه مستشفى بيت حانون ومتنزه لخدمة أهالي البلدة ) .
تنقل المحاصيل وخاصة الحبوب إلى الجرن ، وتوضع على شكل دائرة يسمونها الطرحة ، وتبدأ عملية الدرس وهي عملية متعبة جداً ، ويربط في البغل أو الدابة لوح خشبي - مثبت في أسفله قطع من الحديد على هيئة منشار مسنن - مكان المحراث ، ويصعد الدارس فوق اللوح الخشبي و ينهر بغله أو دابته التي تسير بشكل دائري ، ويستمر على هذه الحال حتى تنفصل الحبوب ، وبعد ذلك يقوم الفلاح بتذريته حيث تتم عملية التذرية في الصباح الباكر وبعد العصر وحسب اتجاه الرياح ، ويستخدم الفلاح المذراة وهي عمود من الخشب لا يتجاوز طوله المتر و نصف المتر، في أحد طرفيه مشط يشبه الكف به حوالي ستة أصابع خشبية وطول الإصبع لا يقل عن خمسة وثلاثين سنتمتراً ويغرف بالمذراة من الطرحة ويقذف ما تحمله المذراة لمسافة أعلى من قامة الفلاح ، فتقوم الريح بإبعاد باقي السنابل من قش وقشور (التبن ) ، أما الحبوب فتعود إلى مكانها على الأرض بعد أن يتطاير التبن بعيداً.
ولقد كان سكان البلدة يتعاونون مع بعضهم حتى يتغلبوا على مشقة العيش والحياة ، كان لابد من هذا التعاون مع توفر النية الحسنة و النخوة والشهامة ، فعندما كان أي رجل يحرث أرضه أو يجني ثماره أو يحصد زرعه ويعرف الناس أنه بحاجة إلى مساعدة إلا وتجد الأخريين قد هرعوا إليه بكل سرور و انشراح يشاركونه العمل ، ويسمون هذه المساعدة العونة ، وهذه كانت من أنبل و أشرف المواقف التي كان يقفها أبناء البلدة مع بعضهم البعض .
أما في العصر الحديث ومع التقدم الزراعي ، أصبح الحصاد بواسطة الآلات المتطورة ، حيث يتم فرز الحبوب عن القش ، ويتم تجميع القش على شكل رزم (بالات ) في نفس مكان الزرع ومن ثم يتم نقلها إلى المكان المحدد عبر الجرارات ( التراكتورات ) ووسائل النقل الحديثة.
بابور الطحين :-
تم إنشاء بابور الطحين في البلدة وهو عبارة عن مطحنة للقمح والشعير والذرة وغيرها من الحبوب في العام 1933 تقريباً و تعود ملكيتها لعائلة النديم ، وقد كان يأتي إليها أهالي القرى الفلسطينية المجاورة مثل قرى دمرة وهربيا ونجد وبيت لاهيا ودير سنيد وغيرها ، وقد استمر عملها حتى نكبة عام 1948 ميلادي واحتلال البلدة من قبل اليهود حيث قاموا بسرقة المواتير والخزانات الخاصة بالمطحنة و حرق ما تبقى منها مما أدى إلى دمارها ، ومكانها الآن مبنى سكني في مسطح البلدة تعود ملكيته لكل من محمود حسن ناصر، وباسل ناصر.
2- الزراعة المروية:- وهي التي تعتمد زراعتها على مياه الآبار كالحمضيات والفاكهة والخضروات .
1- زراعة الحمضيات :-
تميزت بيت حانون بكثرة زراعة الحمضيات بأنواعها المختلفة منها الفلنسيا والبرتقال والليمون في المقام الأول ومن ثم البوملي والكلمنتينا والمندلينا والجريبفوت والفرنساوي وغيرها، وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات في عام 1922 (2765) دونماً ، وكان يصدرالإنتاج إلى الخارج كدول الاتحاد السوفيتي سابقاً وبعض الدول الأوربية وإلى الأردن والخليج العربي وبعض الدول الأخرى حيث كان إنتاج بيت حانون سنوياً أكثر من 34000 طن من الحمضيات .
وتعتبر أراضي بيت حانون من أفضل الأراضي لزراعة الحمضيات ، و أراضيها خصبة جداً ومياهها عذبة ومعظم أراضيها طينية تحتفظ بالماء لفترات طويلة وثمارها من النوع الفاخر ، لذا كان تجار الحمضيات يزورون البيارات في أيام التزهير ويقومون بتقدير عدد من الأشجار ويخمنون قيمة الإنتاج ويعرضون على صاحب البيارة ثمناً للإنتاج الكلي ويتم دفع عربون( مبلغ من المال لحجز الثمار ) في حال موافقة المزارع ، ويتم دفع المبلغ المتبقي عند قطف الثمر.
يتم قطف الثمار بواسطة فنيين متخصصين لذلك ، حتى لا تجرح الثمار ، حيث يتم وضع الثمار في سلات خاصة تنقل بواسطة الأولاد والنسوة إلى مكان التجميع ، ويتم لف كل حبة بأوراق خاصة وتوضع في صناديق خشبية للتصدير الخارجي عبر البواخر، أما ما تبقى من الحمضيات وغير الصالح للتصدير يباع في الأسواق المحلية.
وتعتبر الحمضيات أهم مصدر للدخل في بيت حانون فقد كانت مصدر الرزق الوحيد للكثير من السكان ، كما أنها مصدر لعمل متواصل طوال العام لحاجة الأشجار إلى الري والرش والتعشيب وحراثة الأرض وقطف الثمار وتعبئتها وتشميعها ونقلها وغير ذلك .
وكما هو معروف تزرع الأشجار على شكل سطور متناسقة ومستقيمة ، ويتم سقيها بواسطة بئر خاص للمياه حيث يتم صب المياه في بركة قريبة من البئر، بها فتحات سفلية في جميع الاتجاهات أو حسب الاحتياج ويتم مرور المياه من خلال هذه الفتحات إلى خنادق صغيرة تسمى العمالات ، ويقوم العاملون بالسقي بواسطة الفأس إذ يوجد بين كل سطرين خندق صغير"عمال " يتم من خلاله سقي السطرين ، حيث يقوم العامل بفتح الحوض الخاص بالشجرة بعد أن يمتلئ الحوض الذي قبله وهكذا.
ومع التطور الزراعي أصبحت الآبار تعمل على الكهرباء بدلاً من السولار وتضخ كميات كبيرة من المياه ، كما أنه تم تمديد شبكات المياه من البرابيش والخطوط البلاستيكية ، فأصبحت الأشجار تسقى بواسطة الرشاشات ، مع أن بعض المزارعين لا يزالون يفضلون السقي بواسطة الأحواض ، وذلك لأن التربة تحتفظ بكميات أكبر من المياه .
2- زراعة الفواكه والخضروات :
كانت الفواكه تزرع في الحواكير القريبة من منازل السكان ، والحاكوره هي قطعة من الأرض صغيرة المساحة .
ولقد كانت أهم الفواكه التي تزرع في البلدة الخوخ والسنتروزا والبرقوق والتين والعنب واللوز والمشمش والجميز والصبر ، وكانت هذه الفاكهة غالباً ما تستخدم للاستهلاك العائلي وقلما يعتمد عليها كمصدر للرزق . أما الخضروات فكان معظم أصنافها الباذنجان والفلفل والخس والخيار والبامية والطماطم وغير ذلك كما زرع من البقول الفول والعدس والحمص ...
حفظ وتخزين الخضار والفواكه :
بالنسبة للخضراوات فقد كان أهالي البلدة يقومون بتجفيف البامية والبصل و البندورة وغيرها .
وهناك طريقتان لحفظ البندورة وتخزينها :-
الطريقة الأولى : هي طبخ البندورة حتى تنعقد ثم توضع في أواني فخارية أو زجاجية ثم يغرف منها عند الحاجة .
أما الطريقة الثانية : فهي شق الحبة إلى نصفين ثم تعرض للشمس حتى تجف ثم تخزن ، وعند الاستعمال تقوم ربة البيت بمرسها بالماء .
أما حفظ الفواكه فقد كان يتم حسب النوع ومنها :
التين : كانوا يعرضون التين للشمس إما على سطح المنازل أو على الأرض في مكان نظيف يطلقون عليه اسم ؟ المسطاح - ويحيطون الثمار المنشورة فيه بأغصان الأشجار منعاً للحيوانات من الوصول إليه ويضعون على أغصان الأشجار القريبة من المسطاح قطعة من القماش أو الأواني المعدنية لتحدث صوتا كلما هب الريح و ذلك لطرد الطيور عن الثمار المجففة .
وكانوا يطلقون عليها اسم - القطين - وقد كان من المألوف أن ترى الناس يأكلون القطين جافا أو يغمس مع مزيج من الزيت و السكر أو مزيج من الزيت والدقيق ، وكان يقدم في سهرات الشتاء .
الدبس: وهو عصير العنب بعد تصفيته ثم طبخه على النار بعد إضافة شيء من السكر.
المربى ( التطلي ) : حيث توضع حبات العنب بعد غسلها بالماء وإضافة السكر ووضع المزيج على نار هادئة حتى يعقد تماما و يصبح كالعسل .
الأدوات المستخدمة في الزراعة :-
1- المنساس : وهو عبارة عن عصا طويلة ورأسها له شعبتين حتى يستطيع الحراث مسكه وهو وراء الدابة ، ويضغط بواسطته على فرد الحراث ويوجد في إحدى طرفي المنساس قطعة حديد على شكل مثلث تسمى عبوة ، تستعمل أثناء الحرث لفصل الطين عن الفرد أو السكة .
2- النير: وهو عبارة عن عصا طويلة يوجد فيها ثلاثة ثقوب تربط مع السكة وتجر بحيوانين مع بعضهما.
3- المسماك : هو عبارة عن عصا طويلة نوعاً ما ، في رأسها شعبة لضغط فرد الحراث أو السكة .
4- الدقران : هو عبارة عن عصا طويلة وغليظة ويبلغ طولها أكثر من متر ونصف المتر ، يوجد في أحدى طرفها الأمامي مجموعة من الأصابع الحديدية المثبتة .
5- الفرد : يتكون من مجموعة من القطع المركبة فوق بعضها البعض ، وتتكون هذه القطع من الخشب والحديد حيث إن الجزء السفلي في الفرد من الحديد ، والفرد عريض من أعلى ورفيع من الأسفل ، ويستخدم الفرد التي تجره الحيوانات في حرث الأرض ، و لقد كان يستخدم في المناطق ذات المساحات الصغيرة وينزل الفرد في الأرض حوالي 15 سم .
6- السكة : استعمال السكة نفس استعمال الفرد وتتشابه معه في الصناعة إلا أنها أكبر في الشكل ويجرها اثنين من الحيوانات ، وتكون هذه الحيوانات مربوطة مع بعضها البعض بعصا طويلة تسمى النير ، فيمسك الفلاح بقطعة من الخلف تسمى الكبوسة ويضغط عليها حتى تنزل السكة في الأرض .
7- الشنشرة : تستعمل في حصاد المحاصيل ولها أسنان مفرزة وتصنع من الحديد ولها شكل نصف دائرة ويدها من الخشب ، و أثناء الحصيد يتم مسك الشنشرة بقطعة من القماش خوفاً من العرق .
8- القالوش : يستخدم في حصاد المحاصيل وهو أكبر من الشنشرة .
9- السحلية : تستخدم في حصاد المحاصيل وحجمها متوسط فهي أكبر من الشنشرة وأصغر من القالوش .
10- اللوح ( لوح دراس ) : هو على شكل باب مصنوع من الخشب يبلغ طوله حوالي متر ونصف المتر ، يوجد في أسفله قطعة حديدية طول الواحد حوالي 20سم ، ولكل قطعة مجموعة من الأسنان وذلك لتكسير أغصان الزرع ولهذا اللوح قطعة حديدية في الأمام دائرية الشكل مثبتة في اللوح وتسمى كل واحدة (خدمة) ويتم جرها بواسطة حيوان .
11- المذراة : وهي عبارة عن عصا غليظة يبلغ طولها أكثر من متر ونصف ، ويوجد في آخر طرفها الأمامي عدد من الأصابع الخشبية ، وتستعمل المذراة في فصل الحبوب عن الأوراق ويتم استخدامها وقت هبوب الرياح خاصة التي تهب من الشمال ، ويقوم الفلاح باستخدامها بعد صلاة العصر في أيام الصيف .
10- الغربال : يصنع من الخشب على شكل دائري ويوجد بداخله مجموعة من الحبال ، له فتحات مربعة الشكل تكون الفتحة كحجم حبة القمح ، ويستعمل الغربال لفصل الحبوب عن الأوراق .
المياه:-
كان أول الآبار في تاريخ البلدة هو بئر الساقية في منطقة الساقية التي سميت بقاع البئر وذلك لأنها منطقة منخفضة ويوجد فيها أول بئر في تاريخ البلدة منذ العهد العثماني وكانت النساء تستخدم الجرة والأواني لنقل المياه ، حيث كانت تصطف النساء لتعبئة الجرار من البركة أو الجابية المجاورة للبئر ويرمز لهذا البئر بالرمز C100 ، ومن ثم تم حفر الآبار الخاصة بالمزارعين وذلك لسقي البيارات وبقي هذا البئر هو البئر الوحيد لعامة السكان حتى إنشاء المجلس القروي فتم حفر بئر بجوار المقبرة وتم عمل خزان للمياه في نفس المنطقة و كان يغذي القرية بشكل كامل ، ونتيجة لاقتراب هذا البئر من المقبرة تلوثت المياه في المنطقة وتم ردم البئر وإيقاف ضخ المياه في الخطوط التي كانت مصنوعة من الاسبست والباطون والحديد .
ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ورحيل الاحتلال تم عمل شبكات مياه جديدة في البلدة من مواسير بلاستكية تتحمل الضغط من أنواع (MDPE , UPVC ) في جميع شوارع البلدة وتم حفر وإعادة تأهيل الكثير من الآبار و منها :-
1- بئر المنطقة الصناعية C76 وقدرته الإنتاجية 90 م3/ساعة .
2- بئر الأوقاف ( مديرية الأوقاف العامة) C79 - A وقدرته الإنتاجية 130 م3/ساعة وقد تم إعادة تأهيله في العام 1998 ميلادي ، وتعتبر مياه هذا البئر غير مرغوب فيها لوجود الكثير من الطين والشوائب والأملاح .
3- بئر العزبة C127-A وقدرته الإنتاجية 180 م3/ساعة وقد تم إعادة تأهيله في العام 1997 ميلادي.
4- بئر أبو غزالة C128 وقدرته الإنتاجية 100 م3/ساعة وقد تم إعادة تأهيله في العام 1997 ميلادي.
5- بئر الندىC137 وقدرته الإنتاجية 170 م3/ساعة وقد تم إنشاءه في العام 2003 ميلادي وتعتبر مياه هذا البئر هي الأفضل على مستوى المنطقة لعذوبتها وخلوها من الأملاح.
6- بئر عايدة أبو غزالة C20 وقدرته الإنتاجية 120 م3/ساعة ، وقد تم إنشاءه في العام 2004 ميلادي وتعتبر مياه هذا البئر من أفضل المياه في المنطقة .
7- بئر خديجة C155 وقدرته الإنتاجية 80 م3/ساعة وتم إنشاءه في العام 2007 ميلادي .
وتحتاج البلدة الآن إلى أبار جديدة ويعود ذلك إلى ازدياد عدد سكان البلدة وتأهيل العديد من الشوارع وعمل إفرازات جديدة والامتداد السكاني الواسع في البلدة .
الآبار الموجودة في بيت حانون:
بئر الساقية :
يعتبر هذا البئر الأقدم في تاريخ البلدة ، حيث كان السكان يخرجون منه المياه بواسطة الحبل وكانت الدواب تدور حول البئر لتخرج المياه ، و يأخذ هذا العمل رجل من أهل البلدة طوال العام يقوم بإخراج المياه من البئر مستخدماً دوابه ، ويتم استخراج الماء من البئر عبر القواديس وذلك مقابل أجر سنوي ، يتم أخذه في نهاية موسم الزراعة وذلك من خلال أخذ كمية معينة من الشعير والقمح وغيرها من الحبوب من أبناء البلدة ، وقد كانت النساء يقمن بتعبئة الجرار من البركة المجاورة للبئر وحملها على رؤؤسهن ، ويوجد بجانب البئر بركة مغلقة خاصة بمياه الشرب ، وبركة مفتوحة خاصة لري الخضار ، وكان السكان في حال عدم توفر المياه يذهبون إلى القرى المجاورة لجلب المياه لهم ولمواشيهم وأبقارهم ، وكانت العروس تقوم بنقل المياه في جرة ملونة حتى يتم تمييزها ، وبقي هذا البئر الوحيد في البلدة حتى عام 1933 م ، حيث قام المختار خليل عبد الهادي الزعانين بحفر بئر مياه في منطقة الساقية أيضاً ضمن القطعة رقم 573 ، حيث كانت المياه تكفي أهل البلدة للشرب والزراعة وسقي الحيوانات وذلك لقلة العدد في ذلك الوقت.
وبالتوسع في زراعة الحمضيات في خمسينات القرن الماضي كثر حفر الآبار من في البلدة ، وكانت تكلفة البئر باهظة جداً ، فقد كانت الآبار تبنى من الزفزف والحجارة التي كان يجلبها السكان من البحر ، و يوجد الآن في بيت حانون حوالي 200 بئر للمياه ، وقد أعطيت أبار بيت حانون الرمز C .
وقد قام مجلس قروي بيت حانون بتوصيل مياه الشرب عبر أنابيب خاصة إلى منازل البلدة عام 1972 ميلادي .
تطور الآبار :
يعتبر البئر هو الأساس لزراعة أي أشجار ، فلا حياة بدون ماء ويقول تعالى في كتابه العزيز ( وجعلنا من الماء كل شيء حيء ) صدق الله العظيم .
لقد ساهم بئر الساقية بشكل رئيسي في نشأة وتكوين بلدتنا ، ومع ازدياد عدد السكان وكثرة المعاناة للحصول على ماء وعدم تلبية البئر لحاجة الناس بالشكل المطلوب ، بدأ أهالي البلدة في حفر الآبار وذلك للحصول على الماء لهم ولحيواناتهم وكذلك لزراعة الأراضي التي لم تكن مزروعة إلا بالحبوب والمحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار .
بدأ أهالي البلدة بحفر الآبار منذ ثلاثينات القرن الماضي واقتصر حفر الآبار في بداية الأمر على المخاتير والأفندية وبعض الأغنياء من سكان البلدة ، وكان يستغرق حفر الآبار عدة شهور وأحياناً يقترب من العام ، وذلك لأن الآبار كانت تحفر بالطريقة اليدوية ويتم بناء عدد محدد من المداميك في اليوم خوفاً من الانهيار وتبنى هذه المداميك من أعلى إلى أسفل وكان شكل البئر دائري وذلك لأن الحجارة المستخدمة في البناء لم تكن مستقيمة بل كان شكلها منحني ويتم وضعها بجانب بعضها البعض لتكون دائرة منتظمة ، أما ناتج الحفر من الطين أو الرمال فيتم نقله بواسطة القفة وذلك بربط القفة بالحبل وجرها بواسطة الجمال أو الخيل ويستمر هذا العمل حتى الوصول إلى النزاز وهي بداية الماء ويتم معرفته من خلال خروج التربة الممزوجة بالماء وعندئذ يتم النزول لمسافات محددة وقليلة وذلك لعدم توفر الآلات ، وعند الانتهاء يتم تركيب الماتور وكل ما يلزم للحصول على الماء .
مكونات البئر:
1- السلم : يصنع سلم البئر من الحديد ويتم تركيبه في حفرة البئر حيث يبدأ من أعلى البئر حتى الوصول إلى أسفل البئر ويتم تثبيته جيداً بين المداميك التي يتكون منها البئر حتى يستطيع الشخص النزول والصعود بطريقة سليمة .
2- الصبابات : ويكون عددها ثلاثة ويتم عملها بالتوالي مع بعضها البعض ويتم عمل الأول فالثاني فالثالث وهكذا وذلك خلال فترة تشغيل البئر .
3- الأعمدة (القضبان الحديدية ): وتكون مثبتة على طول البئر بواسطة جسور، وتقوم بنقل الحركة من أعلى إلى أسفل.
4- الماتور : كانت المواتير المستخدمة غالباً ما تكون من نوع Reston وNational و كروسلي وتعمل هذه المواتير على السولار والزيت ، وللآبار القديمة صوت مميز ينام عليه الفلاح ويبلغ قوة الماتور من 18 حصان حتى 57 حصان وذلك حسب مساحة الأرض وكمية الماء التي يحتاجها الفلاح لري الأرض ، فقد كانت كمية المياه المنتجة من البئر تتراوح ما بين ( 30 إلى 60) كوب في ساعة حسب قوة ماتور البئر.
5- الكشاط : وهو مصنوع من الوبر و يقوم بنقل الحركة من الماتور إلى الدرس المثبت على قاعدة ومثبت على جسر مع الأعمدة الحديدة ، ويمر هذا الكشاط على عجلين أحداهما يوجد عند الماتور والأخر عند حفرة البئر .
6- المانولة : وهي أداة التشغيل ويتم وضعها في الماتور ، ويوجد لها فرز خاص وتتم عملية الدوران بواسطة اثنين من الرجال وعند بداية الإسراع في الدوران يتم سحب المانولة .
7- المدخنة : يخرج منها العوادم والدخان .
ملحقات البئر :
1- البركة ( الجابية ): وهي مكان تتجمع فيها المياه التي تخرج من البئر، ويتم توزيع هذه المياه من خلال فتحات في أسفل البركة وذلك لري الأرض.
2- المفجر : وهو مكان تتجمع فيه المياه التي تخرج من البركة من أجل توزيعها على الأشجار من خلال العمالات ويصنع المفجر من الأسمنت والرمال والحصى والزفزف ، وهناك مفجر خاص لتجميع المياه الساخنة التي تخرج من البئر .
الآبار في الوقت الحاضر :
تطورت الآبار تطور كبيراً وقد أصبح من السهل في الوقت الحاضر حفر الآبار، وذلك للاختلاف الكبير في طريقة الحفر، وأصبحت الآبار تحفر بواسطة الآلات ولا يستغرق الحفر إلا بضعة أيام.
تتكون حفرة البئر من حديد سميك على ارتفاع البئر ويتم تركيب هذا الحديد فوق بعضه البعض بواسطة اللحام ، ويتنوع قطر الحديد المستخدم حسب قطر المضخة التي توضع بداخله ويتراوح قطر الحديد المستخدم من 8" إلى 16" في الغالب ، وفي السنوات الحالية أصبح البعض يستخدم المواسير البلاستيكية من نوع u.p.v.c .
في البداية يتم الحفر بواسطة آلة حفر الخوازيق وذلك لعمق يصل إلى 27 متراً ، ومن ثم يتم تنزيل المواسير بعد لحمها بشكل جيد ، و يتم وضع اسطوانة من الحديد أصغر من قطر خط الحديد المستخدم ، وتسمى هذه الاسطوانة الشفاطة وذلك لسحب وشفط التربة الموجودة في أسفل الخط حتي ينزل هذا الخط إلى أسفل بشكل تدريجي ، ويتم سحب وتنزيل هذه الاسطوانة بواسطة ماتور خاص حيث يتم العمل بهذه الاسطوانة حتى الوصول إلى الماء في باطن الأرض والانتهاء من تركيب الخط بعد تثبيته على صخرة وعمل الفجر المناسب واللازم من خلال فتح حفرة في الصخر بواسطة شفاطة ذات قطر صغير وبذلك يكون البئر قد تم تجهيزه ويبلغ ارتفاع الآبار في البلدة من 35 إلى 100 متر .
بعد الانتهاء من عمل الحفرة اللازمة يوجد طريقتين للحصول على الماء :-
الطريقة الأولى : يتم تنزيل مضخة تعمل على الكهرباء تسمى غطاس ويتم وضع طبلون الكهرباء وكل ما يلزم في الخارج ويتم إخراج الماء من خلال بربيش ذو قدرة تحمل عالية يكون مثبت في المضخة في أسفل البئر .
الطريقة الثانية : يتم تنزيل مواسير و وصلها بماتور يعمل على السولار يثبت خارج حفرة البئر ومع ارتفاع أسعار السولار خلال السنوات الأخيرة إزداد استخدام الطريقة الأولى .
تطور عملية الري :
يعتبر الري من أهم العمليات الزراعية التي تحتاج إلى الدقة والضبط والتنظيم ، وقد تطورت أنظمة الري في أنماطها وأساليبها عبر السنين ، فمنذ أن قام أهالي البلدة بحفر الآبار في القرن الماضي بدأ التفكير في إيجاد الطريقة الأفضل لري الأشجار والخضروات ، وأول الطرق التي تم استخدامها كانت طريقة الري السطحي والتي لا تزال مستخدمة في بلدتنا ، إلا أنها الأقل شيوعا في الوقت الحاضر ، وقد كان أصحاب البيارات يعملون أحواض وعمالات خاصة من الباطون ، وتنتقل المياه إلى هذه العمالات من المفجر الذي تتجمع فيه المياه التي تخرج من البئر وذلك حتى تقل عملية الإهدار في المياه ، ومن أهم ما يميز عملية الري السطحي أنها أقل طرق الري تكلفة بالإضافة إلى سهولتها ، كما أنها الأفضل في حالات الري بمياه متأثرة بالأملاح ، إلا أن هذا النظام يصعب استخدامه في الأراضي غير المستوية و المنحدرة والمتعرجة ، وكذلك عدم الانتظام والتجانس في توزيع المياه ، كما أنه يحتاج إلى عمالة مدربة ، ومع التطور الزراعي و صناعة المواسير والبرابيش البلاستكية ، تم اختراع نظام أخر وهو نظام الري بالرش ، و يعتبر هذا النظام من أنظمة الري الحديثة التي واكبت التطور الصناعي ، فهو يتميز بالكثير من الأمور أهمها التوفير في مياه الري والتجانس في توزيعها ، كما أنه أصبح من السهل استخدام المبيدات والتسميد ، إلا أن هذا النظام عالي التكلفة سواء في الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة .
وكذلك تم إدخال نظام آخر وهو نظام الري بالتنقيط والذي يستخدم في ري الخضروات ، ويعتبر هذا النظام من أكثر أنظمة الري المتبعة لما له من أهمية في توفير مياه الري إلى أكثر من 40 % بالمقارنة مع نظام الري السطحي ، وكذلك إمكانية استخدامه للري بالمياه المالحة وقليلة الجودة ، بالإضافة إلى ذلك سهولة إجراء عملية التسميد مع الري بالتنقيط وكذلك ارتفاع كفاءة النظام إلى أعلى من 90 % و قلة الحاجة إلى الأيدي العاملة ، إلا أن هذا النظام عالي التكلفة سواء في الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة .
الأشجار البرية:
وهي الأشجار التي تنمو وتتكاثر بدون زراعة الإنسان لها ومن أهم هذه الأشجار:-
السدر، الغلانة ، العوسج ، العرقد ، الخروع ، الخروب ، السرو ، الصفصاف والأكاسيا وغيرها من الأشجار.
أما بالنسبة لأشجار الكينيا فقد تم زراعتها في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين وتم زراعتها من قبل الإنجليز وذلك عند معسكراتهم وعلى الطرقات ، وزرعت هذه الأشجار من منطقة كراج بيت حانون إلى دير سنيد على امتداد شارع غزة - يافا ( خليل الوزير ) وذلك لوجود معسكر لهم في هذه المنطقة .
النباتات البرية:
وهي النباتات التي تنمو وتتكاثر بدون زراعة الإنسان لها ومن أهم هذه النباتات:-
العقول ، الينبوت ، الحنظل ، السفرجن ، الخلة ، البابونج ، الخبيزة ، القريص ، الحنون ، الحبلق ، الجلفانة ، العنجد ، الخندقوق ، القضاب ، الأقحوان ، شقائق النعمان ، الخرفيش ، السناريا ، الحمصيص ، الرجلة ، الشبرق ، البترنا ، المرار ، العسعيسعة ، الكعوب ، البشع ، البريدة ، الحميض والبصول .
ويعتبر البصول من أهم النباتات التي استخدمت كنقاط فصل بين الأراضي وتصل جذوره إلى أكثر من متر وأوراقه عريضة وسميكة وهو دائم الخضرة طوال العام ولا يحتاج إلى مياه للري.
الطيور:
من المعروف أن الفلاح يهتم بتربية الطيور في بيته، وأغلب الفلاحين يقومون بتربية الطيور في بيوتهم وحقولهم، وتنقسم الطيور إلى نوعين:-
الطيور المنزلية:
وكانت تربى في المنازل وذلك للاستفادة منها وأهم هذه الطيور:-
الدجاج ، البط ، الوز، الحبش وغيرها من الطيور.
الطيور البرية:
انتشرت الطيور البرية لكثرة الأودية والأشجار والمياه في البلدة ومن أهم هذه الطيور:-
الصقر ، الغراب ، الشرقرق ، الديك السمن الأسمر والأحمر ، الدويري ، القمبر ، اللامي ، الخضر ، الهدهد ، العبدة ، الشنار ، والزرزور ، أبوقردان ، الفر ، الزرعي والشنار وغيرها من الطيور المهاجرة تأتي مع فصول السنة المختلفة مثل الكركزان والحسون والصفري.
الحيوانات:
اهتم الفلاح بتربية الحيوانات، وأغلب الفلاحين كانوا يقومون بتربية الحيوانات في بيوتهم وحقولهم، وذلك لأنها كانت تساعدهم في الزراعة وتنقسم الحيوانات إلى نوعين:-
الحيوانات البرية:
انتشرت هذه الحيوانات بكثرة وذلك لوجود الأودية والأشجار والمياه ومنها حيوانات مفترسة مثل ( الضباع ، الذئاب ، النيص ، النمس والثعالب و الواوي الذي انقرض منذ العام 1950 ميلادي بسبب سقوط الثلوج على فلسطين مما أدى إلى موته ).
ومنها النافعة مثل الغزلان والأرانب البرية والتي تنتشر بكثرة في البيارات والكروم.
الحيوانات الأليفة:
لقد استأنس الإنسان بالحيوانات منذ قديم الزمان و اعتمد عليها في المواصلات و من أهم هذه الحيوانات (الحمار ، الجمل ، الحصان ، البغل ) وكذلك استخدم بعضها للحوم والألبان مثل ( البقر ، النعاج ، الماعز ، النياق ) التي اعتمد عليها الفلاح اعتماداً كاملاً ، حيث إن اللحوم كانت تكفي وتزيد وما تبقى منها كان يبيعها الفلاح الفلسطيني للمدن المجاورة ، كما أنه كان يقوم بتصنيع الأجبان والزبدة وذلك لكثرته ، وما أريد ذكره أن الأبقار كانت تنقسم عند الفلاح إلى نوعين:-
العاملات: وهي التي تستخدم في العمل من حرث للأرض ودراسة للمحاصيل، وكان الفلاح يهتم بالعاملات حتى تبقى قوية وقادرة على العمل.
الفضالات: وهي التي كانت تستخدم للحليب ، حيث يتم الاعتناء بها وكانت تذهب إلى المراعي ولا تستخدم في أي أعمال .
تربية المواشي:
يعتبر أهالي بلدة بيت حانون من أكثر الناس تربية للمواشي وخاصة الأغنام ، ولقد كانت تربى الأغنام وترعى بواسطة الرعاة في شرق البلدة والقرى المجاورة وكانت في بعض الأوقات تستمر عدة أشهر خارج البلدة مع الرعاة في سبيل الحصول على غذاء ومناطق للرعي ، ولقد ساعد الأهالي في تربية الأغنام كثرة وجود النباتات والأعشاب و المحاصيل الزراعية و الحبوب خاصة القمح والشعير ، و اهتم أهالي البلدة بشكل كبير بالأغنام حيث كانت في وقت الشتاء والخوف تنام داخل البوايك (المنازل القديمة ) بجوار الناس وهي تمثل مصدر رزق لعدد كبير من أهالي البلدة ، وكان أصحابها يستفيدون منها ، فقد كانوا يشربون الحليب واللبن ويصنعون الجبنة واللبنية ، ومن الجدير ذكره أن الأغنام تناقص عددها بعد نكبة عام 1948 ميلادي وذلك بسبب احتلال بيت حانون من قبل اليهود ، و احتلال المراعي التي كان يعتمد عليها السكان ، وأكثر من اشتهروا بتربية المواشي والأغنام من أهل البلدة وكانوا يملكون أعداداً كبيرة منها هم :-
1- أحمد حسن الزعانين .
2- محمد حسن أبو عودة .
3- عبدربه طه الكفارنة .
4- توفيق عبدالهادي حمد .
5- موسى أحمد الزعانين .
6- سعيد سلمان حمدان .
من كتاب بيت حانون تاريخ وحضارة للمؤلف م. محمود محمد يوسف الزعانين
الطبعة الأولى غزة 2008 - منشورات المركز القومي للدراسات والتوثيق
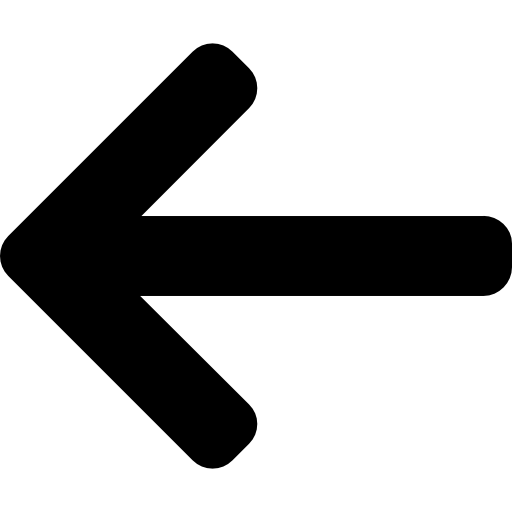



شارك بتعليقك