المقال منقول من موقع الاستاذ الكاتب نبيل علقم
http://nabeelalkam.com/new/news.php?action=view&id=141
د. مصلح كناعنة
(د. مصلح كناعنة أستاذ علم الاجتماع في جامعة بير زيت، وقد ألقى المحاضرة في المؤتمر السنوي الثاني: "نحو مدخل عربي إسلامي لدراسة الإنسان والمجتمع" الذي عقده مركز دراسات التراث والمجتمع الفلسطيني في جمعية إنعاش الأسرة، البيرة، يوم 18/3/2007 ونشرت أعمال المؤتمر في كتاب حرره د. شريف كناعنة)
مدخـل
للهيمنة طرفان: مهيمِـن ومهيمَـن عليه. ولا تتوفر الهيمنة إلا إذا اجتمع أمران: مقدرة المهيمِن على فرض سيطرته على المهيمَن عليه، وعدم تمكن المهيمَن عليه من ردع تلك السيطرة بدايةً والتحرر منها فيما بعد. من هذا المنظور علينا أن ننظر إلى وضعية هيمنة الفكر الغربي على دراسات الإنسان والمجتمع في الوطن العربي. فلكي نعرف بأي اتجاه نسير في بحثنا عن "مدخل عربي ؟ إسلامي إلى دراسة الإنسان والمجتمع"، علينا أن ننطلق من تشخيص سليم لأسباب المشكلة التي استوجبت هذا البحث. فلهيمنة الفكر الغربي على العقل العربي الإسلامي سببان لا يمكن فهم أحدهما دون الآخر: مقدرة الفكر الغربي على فرض نفسه على العقل العربي الإسلامي، وعجز العقل العربي الإسلامي عن إنتاج فكر يضاهي الفكر الغربي فيمنع استفراده بالنفوذ ويحرر العقل العربي الإسلامي من سلطانه المطلق.
بالعودة إلى منابع الفكر الغربي المعاصر، سوف أحاول أن أثبت أن "الحداثة" (تلك الحداثة التي تبهر عقول المثـقـفـين العرب وتـُشـكل الغاية القصوى لطموحاتهم الفكرية) هي أصل المشكلة ومنبع الأزمة التي نعاني منها نحن وبقية العالم. ثم بالعودة إلى منابع الفكر العربي الإسلامي، سوف أحاول أن أثبت أن عجز هذا الفكر عن مضاهاة الفكر الغربي يكمن في إغلاق أبواب الاجتهاد وإطلاق العـنان لمنهج القياس الذي يعادي الفكر المبدع ويكرس الجمود الفكري. وفي النهاية سوف أطرح بعض الأفكار المتعلقة بمستقبل العـقـل العربي الإسلامي والأهداف التي يجب أن يسعى إليها هذا العقل بعد تحرره من هيمنة الفكر الغربي.
الحـداثة
الحداثة كتيار فكري، نشأت في أوروبا نتيجة للثورة الصناعية التي أدت إلى نمو اقتصادي هائـل وظهور الطبقة العاملة، والثورة الفرنسية التي أوقدت الإيمان بتحرر الإنسان وخلاص الإنسانية، ونشوء الدولة القومية الذي اقترن بنشوء النظام البيروقراطي وتـَرَكـُـز الثروة والقـوة في أيدي النخب السياسية (Berman, 1983).
تميزت الحداثة (1) بالتوسع الاستعماري الذي أخضع "العالم غير الأوروبي" لسيطرة أوروبا المباشرة ليتم استغلاله كحشد من المستهلكين لمنتوجات الصناعة الأوروبية وكمصدر رخيص للمواد الخام، بما في ذلك البشر كأيد عاملة مستغلة أو مستعـبـَدة، (2) بنمو اقتصادي سريع أدى إلى ازدياد الأمل بحياة أفضل من ناحية، وإلى اتساع الفجـوة بين من يملك ومن لا يملك من ناحية أخرى، (3) بنشوء ثقافات طبقية منفصلة عن بعضها بشكل شـبه كلي: "كانت ثقافات الطبقات المختلفة بوجه عام منغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض بشكل يكاد يكون كلياً، بحيث كان انتقال الأفراد من طبقة إلى أخرى معدوماً إلا في حالات استثنائية جداً. "كان المرور عبر الحدود الثقافية للطبقات شبه مستحيل، وهذا لا ينطبق فقط على الصعود من أسفل الهرم إلى الأعلى" (Heller, 1990:2).
جوهر الحداثة، كحالة اجتماعية ثقافية وكتيار فكري، هو "مشروع التنوير". و"التنوير" هو الإيمان بالعقـل والعـلم ومقدرتهما على تمكين الإنسان من السيطرة على البيئة الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها، أي على الطبيعة والمجتمع. وعليه فإن التقدم العلمي بمفهوم التنوير يعني ازدياد مقدرة العقـل الإنساني على السيطرة على الطبيعة والمجتمع والتحكم بهما، ومن هنا ينبع الإيمان التنويري الحداثي بأن التقـدم العلمي يؤدي حتماً إلى تقدم الإنسان وتحرر الإنسانية ( Rattansi, 1990& Boyne).
يصف المفكر الألماني يورغـٍن هابرماس هذا الإيمان المطلق بالعقل والعلم على أنه نظرة أحادية البعد للعقلانية، فبموجب هذه النظرة لا يسعى الإنسان لفهم الطبيعة والمجتمع إلا من أجل السيطرة عليهما والتحكم بهما واستغلالهما، وهي نظرة مبنية على الاعتقاد بأن العقل ليس إلا وسيلة استغلالية بحكم طبيعته (Habermas, 1987). إلا أنه من الواضح أن الطبيعة الاستغلالية للعقل الإنساني تنبع في الأساس من الإيمان المطلق للتنويريين الغربيين بالعقلانية كما عـرّفـوها هم، أي بالعقلانية الغربية. فليس كل عقل قادر على السيطرة على الطبيعة والمجتمع واستغلالهما، وإنما العقل الوحيد القادر على ذلك هو العقل الغربي الذي يتمتع بعقلانية مبنية على المنطق الأريسطوطالي، أي "العقل الخالص" (pure reason) كما سماه إيمانويل كانت. إنه العقل الوحيد القادر على أن يـَعـرف، وعلى أن يفهم، وعلى أن يستغل، وعلى أن ينجح في السيطرة على الطبيعة والمجتمع، وبالتالي على أن يـُنتج تقدم الإنسان وتحرر الإنسانية. وهكذا فإن التفريق الحداثي بين "العقل الخالص" الذي يُعنَى بالمعرفة وبين "العقل العـملي" (practical reason) الذي يُعنى بالأخلاق العملية، أدى إلى التفريق بين الغرب وغير الغرب. وهكذا أدى الإيمان الحداثي بمقدرة العقل على التحكم بالطبيعة إلى الإيمان الحداثي بمقدرة الغرب على التحكم ببقية العالم كما أن الإيمان بواجب الإنسان العقلاني في السيطرة على الطبيعة من خلال العلم، أدى إلى الإيمان بواجب، وحق، الإنسان الغربي في السيطرة على شعوب العالم من خلال "التحديث" (modernization) (Rorty, 1979; Trouillot, 1991).
هذا الجانب من الحداثة مرتبط بجانب آخر بالغ الأهمية ويحتاج إلى شرح مطول. فالمنطق الوضعي في الفلسفة الواقعية (realism) التي سادت الفكر الأوروبي في فترة ما قبل الحداثة، كان مبنياً على الإيمان بـ "المحاكاة الساذجة"، أي بالتماثل المباشر أو التطابق الكامل بين الواقع والنظرية، وبين المضمون والهيئة، وبين الشيء والمفهوم الذي يُمثـله ويُعـبر عنه، وبأن المعنى كامن هناك، في الواقع المرئي والمدرَك، ليتم الكشف عنه ووصفه من خلال العمل الفني أو الأدبي أو العلمي (رسـل، 1983). وجاءت الحداثة كردة فعل على هذه النظرة "السطحية الساذجة" للواقع. ففي الحداثة لا يوجد تماثل مباشر أو التطابق الكامل بين الواقع كما هو وبين الواقع كما يعـبَّر عنه في النظرية العلمية أو الهيئة الفنية أو النص الأدبي. فالنظرية في العلم والهيئة في الفن والنص في الأدب ليست ( ولا يجب أن تكون) مجرد "صورة مرآة" ولا مجرد وصف مباشر للواقع كما هو هناك، وإنما هي الوسائل العقـلية التي تزودنا بمعنى الواقع، وبجوهر الأشياء، وبحقيقة الوجود، وبقوانين الطبيعة، من أجل السيطرة على طبيعة الواقع وواقع الطبيعة في العالم واستغلالهما لتقدم الإنسان وتحرر الإنسانية. إلا أن معـنى الأشياء ليس في ظواهرها ولا يبدو لنا على السطح لنلتقطه بحواسنا ثم نصفه في النص أو نعبر عنه في الهيئة أو نمثله في النظرية، بل هو مستتر من خلف الظواهر ومختبئ تحت طبقات متعددة من المظاهر الحسية للأشياء، ولذلك يجب أن نستنتجه استنتاجاً ونحل ألغازه ونميط اللثام عنه (Bertens, 1986). ففي منظور الحداثة، ما يهمنا ليس هو الواقع كما يبدو للحواس، وإنما هو الواقع كما ينظمه العقـل... وما له قيمة في نظر التنوير الحداثي هو ليس الأشياء في مهابتها (the sublime) (أي في شكلها الطبيعي قبل أن يَصقلها ويُشكلها الإنسان) بل الأشياء في جماليتها (the esthetic) (أي كما يصقلها ويشكلها وينظمها الإنسان) (Lyotard, 1984). فقط حين يُنـَظم العقل ظواهر الواقع... فقط حين يفرض العقل نظامه على الواقع، يستطيع العقل أن يخترق السطح ليصل إلى المعنى والجوهر، ويصبح للواقع معنى، ويصبح للأشياء أهمية، ويصبح العالم قابلاً للمعرفة والفهم والسيطرة والاستغلال من أجل تقدم الإنسان وتحرر الإنسانية. وعليه فإن المعنى لا يكمن في الواقع كواقع، وإنما يكمن في الواقع الذي يتم تنظيمه وإعادة بنائه في النظرية أو الهيئة أو النص، من قِبـَل العقل الحداثي المستنير الذي هو وحده (بحكم عقلانيته) يملك القدرة على اختراق السطح والغوص في بواطن الأمور والكشف عن طبيعة الطبيعة. وهنا يجب التنبيه إلى أن اعتقاد معظم ممارسي العلم في مجتمعنا العربي بأن المنهج الإمبيريقي (التجريبي) هو منهج واقعي، هو اعتقاد خاطئ على المستوى الفلسفي، فمع أن هذا المنهج يعتمد على معطيات الحواس، إلا أنه لا "يكتشف" المعنى في معطيات الحواس ذاتها ولا في الواقع الذي تأتي منه، بل في تنظيم هذه المعطيات وتصنيفها وتحليلها من قبل العقل الباحث، بمعنى أن "الحقيقة" لا تأتي من الواقع مع معطيات الحواس، بل تأتي من العقل الباحث مع النظام والترابطات التي يفرضها هذا العقل على المعطيات ثم يُخضِع المعطيات لها ولمنطقها الخاص.
بما أن المعنى مستتر خلف المظاهر وكامن في التنظيم العقلاني للواقع، فإن اكتشاف معنى الأشياء يعني في منظور الحداثة "اختراق سطح الأشياء بواسطة التحليل التفسيري" (Bertens, 1986:15) واختراق سطح الأشياء بواسطة التحليل التفسيري لا يتأتى إلا للإنسان الغربي، لأنه هو الوحيد الذي يملك عقلاً عقلانياً، وبالتالي يملك القدرة على تنظيم الواقع بشكل عقلاني. إلا أن هذا الشرط غير كافٍ على الرغم من أنه ضروري، فالتحليل التفسيري "الصحيح" واكتشاف المعنى "الحقيقي" للأشياء يتطلبان قدرات فكرية ومهارات جمالية ومؤهلات فلسفية ومواصفات نفسية خاصة لا يتمتع بها، في الغرب نفسه، إلا من يتمتعون بامتياز الحصول على المعرفة والعلم والثقافة، وهو امتياز تحدده الثقافة الطبقية والنوع الاجتماعي(Huyssen, 1986). ولذا فإن رجل النخبة (أي الرجل من طبقة النخبة) هو وحده القادر على اكتشاف "المعنى الحقيقي" للأشياء، وإدراك جوهر الأمور، وفهم حقيقة الواقع، واستيعاب مغزى الوجود، وتذوق الجماليات، وتقدير مكنونات الطبيعة، وبالتالي التحكم بالطبيعة والمجتمع والمساهمة في تقدم الإنسان وتحرر الإنسانية (المصدر السابق، وكذلك Keller, 1985 ورسل، 1983). إن فن الحداثة، وموسيقى الحداثة، وأدب الحداثة، وعلم الحداثة، وفلسفة الحداثة، هي كلها وبدون استثناء نخبوية وذكورية ليس فيها وجود للمرأة ولا للعامة، مع وجود فجوة هائلة تفصل بين النخبة التي تفهم وتـُقـدر الفن والموسيقى والأدب والعلم والفلسفة وبين الجماهير التي لا تفهم هذه الأمور ولا تقدرها؛ بين الرجل الذي يمارس تجربة الحداثة وينفذ مشروعها التنويري وبين المرأة التي لا دور لها في هذا كله.
لقد أدى هذا إلى إنتاج أبرز ما تمتاز به الحداثة وأوضح مؤشر على طبيعتها، وهو مجموعة من أزواج المتناقضات تعرف بـ "مزدوجات الحداثة" (Trouillot, 1991: 34):
الواقع : العمق السـطح
الجوهـر المظهـر
النظام الفوضى
النظام
الواقع في الصيغة الواقع في الواقع
المعنى الوجود
الأشياء: شكل جمالي (مصقول) شكل جمالي (مصقول)
مثقف (مهذب) طبيعي
قابل للمعرفة غير قابل للمعرفة
الشيء كموضوع للمعرفة الشيء في ذاته
العقـل: عقلاني لاعقلاني
منطقي لامنطقي
معرفة من الخارج معرفة من الداخل
معرفة علمية معرفة حدسية
الإنسان: عصري غيرعصري
حداثي ما قبل-حداثي
ثقافي طبيعي
حضاري بدائي
المعرفة: ذات معنى بدون معنى
صحيحة خاطئة
مهمة غير مهمة
علمية غير علمية
... = ...: الغـرب الشـرق
الأبيض غير الأبيض
النخبة الجماهير
الثقافة العليا ثقافة العامة (الفلكلور)
الثقافة الطبيعة
الرجل المرأة
العقل الجسـد
الرأس القلـب
الفكر العاطفة
الذهن الغريزة
علمي خطابي/عاطفي
العلم الخيال/العقيدة
هذه الأزواج من المتناقضات في الحداثة لم تـُنتِج فقط التناقض والصراع بين ذَكـر الثقافة وأنثى الطبيعة، وبين الغرب العقلاني والشرق اللاعقلاني، وبين النخبة المثقفة والجماهير الساذجة، بل هي أنتجت كذلك التناقض والصراع داخل ذات الفرد الواحد. فالذات الحداثية ممزقة بين العقلانية واللاعقلانية... بين الفكر والغريزة... بين رغبة العقل في المعرفة ورغبة الجسد في الانغماس في العيش (Lunn, 1985). ففي محاولتها اليائسة لفرض النظام والهيئة المصقولة على المظهر اللامنتظم لموضوع المعرفة، مزقت الحداثة الذات الإنسانية العارفة. وبخلاف الذوات المنسجمة لعهد الواقعية، فإن ذوات عهد الحداثة تنوء تحت وطأة الصراع الداخلي ويمزقها التناقض بين الحرارة الدموية للقلب الذي ينبض بالحياة وبين البرودة الهندسية للعقل الذي ينظر إلى الحياة من عليائه... من "أبله" دوستويفسكي، إلى الأجساد المشوهة في لوحات بيكاسو، إلى التردد بين صخب العاطفة وصمت العقل في مقطوعات شايكوفسكي، إلى الصراع الأبدي بين "الإد" و "الأنا" عند فرويد، إلى "الإنسان الأعلى" لنيتشه الذي لا يبارح فراش المرض والموت، إلى العجوز الذي يصارع الأقدار بمفرده عند هامنغوي، إلى التخبط اللانهائي بين "الوجود والعدم" وبين الفكر والهلوسة لدى سارتر. وهكذا تـَحـوّل مشروع الحداثة في النهاية إلى لهاث محموم للتغلب على الصراع، وإلى سلسلة من المحاولات الفاشلة للتوفيق بين المتناقضات وتوحيد التجربة الحياتية التي مزقتها الحداثة نفسها (Lyotard, 1984).
وبما أن الحداثة حصرت المعرفة العقلانية والصقل الجمالي للواقع في النخبة المثقفة التي تحتـل قمة الهرم الاجتماعي، فقد كانت مضطرة إلى مَأسَسة العلم والفن والأدب لكي تمنع انزلاق "العقلاني" و"الجمالي" إلى كـتـل الرعاع وعامة الجماهير(Huyssen, 1986). إن الأكاديميا (الجامعة)، والغاليريا (معرض الرسومات)، ودار الأوبرا، والمسرح، وصالات الأدب، وهي مفاخر الحداثة بلا منازع، كلها أُنشِئت في أرقى الزوايا من أرقى الأحياء في أرقى المدن، بعيداً عن الفلاحين الجهلة في الحقل، والعمال السذج في المصنع، و "حثالة المجتمع" في أحياء الفقر!
يتضح لنا من خلال التعمق في فكر الحداثة أن محاولة الإنسان للسيطرة على الطبيعة والمجتمع ليست إلا محاولة العقل لافتراض معايير كلية وشمولية ومطلقة للحقيقة، تكفـل صحة ومصداقية البحث العلمي من خلال قوانين فوق-طبيعية وقبل-تجريبية مفروضة مقدماً، تقول لنا ما هو الواقع وكيف يبدو وكيف تتصرف الأشياء فيه. وبكلمات أخرى، فإن الأسس الإبستمولوجية والأنطولوجية المفروضة من العقل على الواقع مقدماً (أي قبل التجربة) هي التي تتيح إمكانية معرفة العالم الذي يجب السيطرة عليه والتحكم به. هذه "الأسُسية" اللاتجريبية تعكس الإيمان الحداثي بأن الإنسان الغربي، بعقله العقلاني، "يملك أرضية امتيازية لليقين المعرفي والسلطة الفكرية التي لا يمكن الارتياب بها أو الخروج عليها" (Margolis, 1986:38 وكذلك الخولي، 2000). وهذه "الأسسية" المطلقة هي التي أنتجت النظريات الكبرى للحداثة، وهذه النظريات الكبرى هي نوع جديد من الميتافيزيقا التي تفرض نفسها على التجربة ولا تخضع للتجربة، بدءاً بـ "كوغيتو" ديكارت ومرورا بمقولات كانت الإثني عشر، ثم تجريبية كونت وهوبز، ثم ديالكتيك هيغل وتاريخه الشمولي، ثم تطورية داروين، ثم ليبيدية فرويد، ثم الوظيفية البنائية لرادكليف براون، ثم فينومينولوجية هوسرل وبرغسون. كل هذه النظريات الكبرى هي "مجرد رغبة في إيجاد أسس يجب أن نتشبث بها وأطر يجب أن لا نخرج منها" (Rorty, 1979:315).
أما فيما يتعلق بالنظريات الاجتماعية على وجه الخصوص، فمنذ منتصف القرن التاسع عشر سيطرت على الحداثة اثنتان من مثل هذه النظريات "الأسُسية" الكبرى: المادية التاريخية لماركس، والوظيفية لدوركهايم. كلتا هاتين النظريتين "تصران على أن اكتشاف المبنى الاجتماعي وديناميكياته الاجتماعية كواقع مستقل...سوف يحرر دراسة المجتمع من قبضة الميتافيزيقا والآراء الذاتية الصرفة، وسوف يُحـْدِث ثورة في الممارسة الاجتماعية" (Crook, 1990:48). وكلٌ منهما تدعي أنها هي القادرة على طرح المقولات السليمة للفهم العلمي للمجتمع والتاريخ، والمبادئ الصحيحة للحداثة والتنوير. إلا أن كلاً من هاتين النظريتين تدعي، وبتزمت متطرف، أنها هي وحدها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحداثة وثمارها الموعودة من التقدم والرخاء والمساواة والحرية. وعلى الرغم من أن كلتا النظريتين تدعيان أن المجتمع هو واقع مستقل خاضع لنمطه الخاص من العلاقات السببية، فإن كلاً منهما تدعي أن قوانين الواقع الاجتماعي لا يتم اكتشافها ومعرفتها إلا من خلالها، وليس من خلال النظرية الأخرى؛ إما من خلال المادية التاريخية فقط، وإما من خلال الوظيفية فقط. ولهذا يذهب ستيفن كروك إلى حد القول: "إن ماركس ودوركهايم لا يمارسان العلم، بل ينتجان برامج تملأ العلم بمقولات ميتافيزيقية... كلاهما يقرر لنا ما هو الواقع وكيف ننظر إليه، وكيف يمكننا معرفته، قبل أي بحث أو الدراسة" (Crook, 1990:52).
أزمة الحـداثة
في منتصف القرن العشرين أصبح فشل مشروع الحداثة وعجزها عن تحقيق وعودها بالرخاء والمساواة والحرية واضحاً. لقد تمكنت الحداثة من اضطهاد وتهميش الأطراف الضعيفة من أزواج المتناقضات (كالمرأة، والعالم الثالث، والأجانب، والفلاحين، وجماهير العامة بشكل عام)، ولكنها لم تتمكن من القضاء عليهم ومحوهم من الوجود، فظل هؤلاء يمارسون الحياة في الظل ويجمعون قواهم من وراء الكواليس، إلى أن أصبح تأثيرهم على معايير الفن والأدب والعلم غير قابل للإنكار أو الرفض. وفي نفس الوقت لم تتمكن الحداثة من التوفيق بين المتناقضات التي أوجدتها، وعوضاً عن ذلك حاولت أن تسيطر على تلك المتناقضات من خلال دمجها في أنظمة شرعية للتمييز واللامساواة، كالكولونيالية والرأسمالية والسيادة الذكورية في العلوم والاحتكار المُمأسَس للحقيقة ووسائل إنتاجها (Lyotard, 1984). ومن ناحية أخرى فإن مَأسسة الفن والعلم من أجل الحفاظ على طابعهما النخبوي جعلت حرية الفن وحيادية العلم وموضوعية الحقيقة من المستحيلات، بل من مبتذلات الفكر النخبوي. فالمعايير التي تقرر ما هو جمالي وعلمي وحقيقي لم يعد يحددها "العقل الخالص" بناء على مقولاته المطلقة، بل أصبح يحددها أصحاب القرار السياسيون بناء على مصالحهم الذاتية أو الطبقية. فمَأسسة الفن والعلم سَيـَّستهما وجعلتهما شريكاً في اللعبة البيروقراطية للجامعة والمعرض والمسرح والدولة. أما النظريات الكبرى التي كان من المفروض أن تمنح الشرعية للولوج إلى المعرفة، فقد انتهى بها الأمر إلى أن تمنح الشرعية للولوج إلى مراكز القوة السياسية، وبدل أن تحقق المشروع التنويري للحداثة وتـُمَكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة والمجتمع، حققت المشروع المناقض له ومكنت المؤسسات من السيطرة على الفرد (Fox, 1991). وهكذا فشلت الرأسمالية والماركسية والبروتستانتية والفاشية والديمقراطية الاشتراكية في تحقيق السلام والأمن والمساواة للإنسان الغربي، وفشلت كلها في بناء "المجتمع السليم" الذي يسوده التضامن العضوي ويوجهه الهدف الإنساني الأسمى، وتركت الفرد وحيدا عاريا في مواجهة ألغاز الحياة المعاصرة (Boyne & Rattansi, 1990). وهكذا فإن إنسان نيتشه الأعلى ؟ السوبرمان، العارف لكل الحقائق والقادر على كل شيء ؟ انتهى به المطاف كرجل بلا هوية ولا ملامح، يمزقه الارتباك، جالس في زاوية مظلمة في مكان لا موقع له، ينتظر بقلق محموم مجيء "غـودو" الذي لا يأتي أبداً... ويُسدل ستار الحداثة، ونبقى نحن وذاك الرجل لا نعرف من هو "غودو"، وما هو، ومن أين يأتي، وهل سيأتي في يوم من الأيام أم لا.
ونتيجة لهذا الفشل برز إلى الوجود في الغرب تيار من المفكرين الحداثيين النقديين الذين أخذوا يحاولون تشخيص المرض والعثور على أسباب فشل الفكر الحداثي في تحقيق وعوده التنويرية. فهايدجر وماركوزا وفيتغنشتاين وهابرماس في الفلسفة والفكر، والتعبيريون وحركة الأفانت-غارد في الفن، وت.س. إليوت وجيمس جويس وفيرجينيا وولف في الأدب؛ كلهم ساهموا في النقد الذاتي للحداثة (Pool, 1991). ولكن هذا النقد الذاتي كان يعاني من نقطة الضعف التي يعاني منها كل نقد ذاتي، وهي أن النقد يكون مبنياً على نفس الأسس والمقولات التي ينتقدها. فالنقد الحداثي لم يَسعَ إلى هدم المشروع التنويري بل إلى إنقاذه، ولم يشن الحرب على الحداثة بل من أجلها (Frankel, 1990).
عصر ما بعد الحداثة
ظهر تيار ما بعد الحداثة (postmodernism) كردة فعل على الظروف الخاصة التي ورثها عصر ما بعد الحداثة من الحداثة ومشروعها التنويري. فكلما ازداد فشل الحداثة في تأمين السلام والأمن والحرية والمعنى للإنسان، كلما أصبح العلم وأصحاب القرار من خلفه معنيين ليس في اكتشاف الحقائق، بل في اختراع آلات أوتوماتيكية تجعل حياة الناس محتملة، وفي اكتشاف إمكانيات جديدة لتسويق هذه الآلات (Adorno, 1977)، وهذا أدى بدوره إلى نشوء وسائل الإعلام التي لا تعرف الرحمة، و"العمليات التكنولوجية والصناعية التي لا يمكن السيطرة عليها" (Roberts, 1990:12)، وصناعة شريط التجميع التي تحول كل شيء تقريبا إلى بضاعة للتسويق وبسرعة هائلة (Callinicos, 1990). هذه التطورات حولت النظريات الحداثية الكبرى إلى كماليات لا فائدة منها، فكما يقول لويتارد: إن العلم والتيكنولوجيا لا يحتاجان إلى الشرعية الإبستيمولوجية ولا إلى معايير للحقيقة طالما أنهما ينتجان آلات متطورة ويعثران على وسائل مربحة لتسويقها (Lyotard, 1984).
وفي نفس الوقت شهد هذا الجيل من "المستهلكين السلبيين" في الغرب ثورات التحرر من الاستعمار في "الهامش البعيد"، وشهد كذلك انتفاضة "الهامش القريب" في عقر دار الرأسمالية الغربية نفسها. وفي هذه الأثناء بدأ المثقفون والمتعلمون والمفكرون من مجتمعات العالم الثالث بالوصول إلى الغرب والصعود على مسرح الأحداث، جالبين معهم "زوايا جديدة للنظر وأبعاد جديدة للفهم والمعرفة" (Clifford, 1986:9).
تيار ما بعد الحداثة
نستطيع أن نجزم أن ما بعد الحداثة هي محاولة لتوسيع وتعميق النقد الذي بدأه الجناح اليساري من الحداثة المتأخرة. ولكن بسبب الظروف الخاصة لعصر ما بعد الحداثة، والتي وصفناها أعلاه، فإن تيار ما بعد الحداثة مختلف ومنفصل كلياً عن الحداثة اليسارية المتأخرة، من حيث أن تيار ما بعد الحداثة لا يكتفي بالنقد الإصلاحي بل يسعى إلى تقويض الأسس المعرفية للحداثة ومشروعها التنويري. وقد تأثر تيار ما بعد الحداثة بشكل جوهري بالحركة الهدمية (أو ما بعد البنائية) التي تدعي أن كل موضوع للمعرفة يتشكل في "خطاب" أو "منظومة من المفاهيم"، ولا وجود له كموضوع للمعرفة إلا من خلال الخطاب أو منظومة المفاهيم التي يتشكل فيها. فبما أن اللغة هي دائماً وأبداً وسيلتنا الإلزامية لمعرفة وفهم العالم، فإنه ليس من الممكن أن نتخطى المعاني التي ينتجها الخطاب اللغوي. فمعرفة الأشياء تكمن في العلاقة بين الرمز والمفهوم، وليس في العلاقة بين الرمز والأشياء في الخارج (Derrida, in Roberts, 1990). وبتأثير دي سوزير وفيتكينشتاين، تنفي ما بعد الحداثة إمكانية الوصول إلى الواقع في وجوده المستقل، وذلك لأن الواقع لا يصل إلينا، ونحن لا نصل إليه، إلا من خلال الرموز والمفاهيم، وليس لهذا الواقع من أهمية أو معنى إلا حين تتدخل اللغة بيننا وبينه فتـُشكله وتـُحـوّله إلى "موضوع" للمعرفة الذهنية. وباختصار، فإن ما بعد الحداثة حولت العلم من "نصوص تعبر عن حقائق" وتراكـُم للحقائق السليمة التي أُُثبتت صحتها ولم يُثبَت خطؤها، إلى مجموعة من "الألعاب اللغوية وألعاب القوة" التي لا علاقة لها بالحقيقة وإنما بالمعنى والتأثير. وقد أوصل هذا ليوتارد إلى أن يقول أن القوة، وليس الحقيقة، هي معيار العلم وممارساته المختلفة في عالم ما بعد الحداثة (Lyotard, 1984).
بناءاً على هذه النظرة للعلم، أعلنت ما بعد الحداثة رفضها لكل النظريات الكبرى، وأنها "تشن حربا على التوتاليتارية الفكرية" التي أنتجتها الحداثة (Lyotard, 1984:81). ووصل الأمر بمفكري ما بعد الحداثة إلى أن يعلنوا بكل إصرار أن ما بعد الحداثة ليست حركة ولا نظرية ولا مذهباً، وإنما هي مجرد تيار يجري في تضاريس صعبة؛ مجموعة من المستائين الذين اكتشفوا علل الحداثة ولذلك يرفضون تصديق أكاذيبها أو احترام اختلاقاتها، وهمهم الوحيد هو محاربتها وتقويض أسسها وتخليص العالم منها، وفتح ساحة الفكر لكل أنواع الممارسة وأشكال المعرفة، ولكل الأطراف على حد سواء.
وهكذا نرى أن ما بعد الحداثة هي أداة هدم وليست مشروع بناء، وأنها لا تطرح أي بديل للحداثة سوى حق الجميع في طرح البدائل التي يريدونها، وأن كل ما تبنيه هو من قبيل "كل شيء ممكن؛ كل شيء مفتوح؛ ليست هناك حدود ولا حق لأحد أن يرسم حدوداً؛ لا أحد يملك الحق في احتكار الحقيقة وفرضها على الآخرين، فالحقائق نسبية دائماً ولا وجود لحقائق مطلقة."
نحـن والحداثة
إذا كانت الحداثة قد فشلت واعترف الغرب نفسه بفشلها، فلماذا ما زلنا نحن العرب نعتبرها شرطاً ومقياساً للتقدم والنجاح؟ ... إذا كان مفكرو الغرب أنفسهم يصرحون بكفرهم بالحداثة ويعلنون الحرب عليها، فلماذا لا نزال نحن العرب نؤمن بها، ونقدسها، ونضعها نصب أعيننا كمثالنا الأعلى، ونمأسسها في جامعاتنا ومعاهدنا، ونـُروِّج لها في مناهج تدريسنا، ونزرعها في عقول أجيالنا القادمة؟ (انظر مثلاً زيادة، 1987).
لقد حاولت من خلال هذا الوصف المختصر للحداثة أن أوضح أن هيمنة العقل الغربي علينا هي جزء لا يتجزأ من مشروع الحداثة نفسها، وأن تهميشنا والاستخفاف بفكرنا هما نتاج مباشر لجوهر الفكر الغربي الحداثي، وأن الحداثة التي تعشش في فكرنا هي المخلفات التي أسقطها الغرب الاستعماري في عقولنا لتعيش فينا بعد موتها في الغرب، معتقدين أن الحداثة حي سبب تقدمنا ولحاقنا بالغرب في حين أنها في الواقع علة تخلفنا وإلحاقنا بالغرب.
إن الحداثة الآن تصارع الموت في الغرب، وكل يتفاخر بأنه قاتلها، والظاهر أنه لا أحد يرغب في امتلاك إرثها وإنجاب نسلها سوى نحن العرب وباقي شعوب "الهامش البعيد". لقد آن الأوان لأن ندرك أن هيمنة العقل الغربي علينا تنبع بشكل مباشر من الحداثة ومنتجاتها الاستعلائية والاستغلالية، وأنه لا يتم التحرر من هذه الهيمنة إلا من خلال نبذ الحداثة وفلسفتها ومناهجها وفك الارتباط بينها وبين مفهومنا للعلم والمعرفة والتقدم. وبما أن الغرب لا يطرح (أو لا يقدر أن يطرح) بديلا للحداثة، فإن هذا يفتح أمامنا نحن العرب فرصة ذهبية للمساهمة في طرح وتطوير بديل للمعرفة الإنسانية، لصالحنا ولصالح الإنسانية جمعاء، بدل أن نظل فرسانا يدافعون عن قائد على فراش الموت، وهو لا يرجو لنا خيرا. ولكن كيف لنا أن نساهم في طرح وتطوير بديل للمعرفة الإنسانية ونحن غير قادرين حتى الآن على أن نحرر أنفسنا من هيمنة العقل الغربي الحداثي وهو على فراش الموت؟
أَنْ نلقي اللوم كله على الحداثة وجبروتها وما خلفته في عقولنا، يعني أن نعفي أنفسنا من المسؤولية ونعمي أعيننا عن علاتنا. فعجزنا عن التحرر من هيمنة العقل الغربي الحداثي على الرغم من ضعفه وسقمه، يدل على أن العلة فينا؛ في عقلنا العربي الإسلامي، وهذا ما يجب أن نكتشفه ونفهمه ونعترف به كشرط للخروج من دور المفعول به إلى دور الفاعل.
عـلة العقل العربي (يتبع)
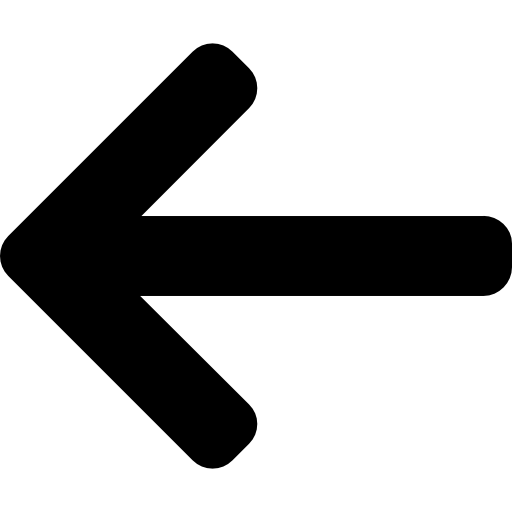



شارك بتعليقك