مصدر المقال :
موقع الكاتب الاستاذ نبيل علقم
http://nabeelalkam.com/new/news.php?action=view&id=142
نحو تحرير العقل الإنساني من هيمنة الفكر الغربي (2)
د. مصلح كناعنة
عـلة العقل العربي
بقي العقل العربي في حالة تـَشـَكل خلاق خلال القرنين الأولين للهجرة، مع ما رافق ذلك من تعدد التيارات الفكرية ذات المناهج المختلفة، كل يسعى إلى الحقيقة بطريقته. وكان العقل العربي الإسلامي في هذه الفترة عقلاً اجتهادياً مفكراً ومحللاً، يُخضِع النص للفكر، وليس العكس (الشكعة، 1983). يُروى عن الإمام أبي حنيفة النعمان أن أحدهم روى على مسامعه حديثاً نبوياً يقول: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، بمعنى أن للبائع والشاري الحق في التراجع عن صفقة عقداها إذا برحا مكان عقد الصفقة. فقال أبو حنيفة: "أرأيت إن كانا في السجن؟ أرأيت إن كانا في سفر؟" بمعنى أن البيعان ليس بالضرورة بالخيار ما لم يفترقا (النمر، 1986: 42). وما نشهده هنا هو أن أبا حنيفة رفض الأخذ بحديث نبوي صريح وصحيح، وأخذ برأي العقل بناء على ربط مضمون النص بمتغيرات الواقع وملابساته (ولو حدث هذا الآن لتم تكفير الفاعل والطعـن في سلامة عقله).
ولم يكن ما فعله أبو حنيفة هنا فريداً أو خارجاً على المألوف، بل كان منسجماً مع المناخ الفكري السائد في ذلك الحين، وهو مناخ الاجتهاد المبني على التفكير وإعمال العقل في عالم متغير وملابسات دنيوية طالما أن ذلك لا يمس العقيدة وأركان الدين، وهو مناخ ينسجم في الأساس مع تعاليم الرسول الذي فرق بين حقائق الدين الأزلية وحقائق الدنيا المتغيرة (العظمة، 1996)، فقال مخاطبا المسلمين: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم"، ولم يَدَّع ِ؟وهو رسول الله- أنه أعلم الخلق بكل شؤون الدنيا وعلى مر كل العصور، كما يدعي أهل القياس من التابعين حتى يومنا هذا. وتقول الآية 3 من سورة المائدة، وهي من آخر ما أنزل من القرآن وليس فيها منسوخ: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا." فالآية تقول "اليوم أكملت لكم دينكم" ولا تقول "اليوم أكملت لكم دينكم ودنياكم"، لأن الدنيا متغيرة مستجدة لا تكتمل، ومعرفتها وفهمها يظلان رهنا بالمتغيرات والمستجدات، على عكس العقيدة، وهي معرفة الذات الإلهية التي اكتملت باكتمال القرآن والسنة (الدمشقي، 1992).
إلا أن هذا المناخ الفكري المنفتح اختفى من تاريخ المعرفة الإسلامي مع تبني منهج الشافعي في الشريعة، والأشعري في العقيدة، والغزالي في الفلسفة، بصفتها السبل الوحيدة للوصول إلى الحقيقة. ولظروف سياسية، اختزلت الاختلافات بين الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل) إلى مجرد عدم اتفاق في الفروع الفقهية وليس في المنهج، وصنفوا على أنهم ينتمون إلى منهج واحد، منهج أهل السنة والجماعة (أبو زيد، 1992). وابتداء من القرار السياسي للخليفة العباسي المتوكل بقفل باب الاجتهاد واعتماد الأئمة الأربعة مصدراً للإسلام الصحيح، أصبح العقل العربي الإسلامي يدور في نطاق آليات فكرية تعتمد على الإسناد، وتسندها في كل الأحوال أقوال أحد أئمة السنة الأربعة أو تابعيهم (نافعة وبوزورث، 1978). وبذلك جـَمُد العقل العربي الإسلامي وانفصل عن الواقع المتحرك والمتغير، ولا يزال إلى هذه اللحظة (الجابري، 1985). وما يميز العقل العربي الإسلامي بصفة عامة هو أنه لا يزال إلى الآن أسير عمليات قياس، وقياس على قياس على قياس. وبحكم كون هذا العقل أسيرا للقياس فإنه يأسر الحاضر والمستقبل في الماضي، ويأسر الواقع في النص، ويأسر الحقيقة في من قالها لا في أسبابها ولا في نتائجها، وبالتالي يأسر عملية التفكير في مقارنة المظهر لا في تحليل الجوهر.
صحيح أنه كانت هناك محاولات لخلق عقل عربي إسلامي متحرك وفاعل ومتمرد على جمود المنهج القياسي، تمثلت في محاولات ابن خلدون في التاريخ والمجتمع، وابن حزم في الفقه والعقائد، وابن رشد في الفلسفة والمنطق. إلا أن هذه المحاولات جاءت بعد فوات الأوان، حين أصبح العقل عبدا للقياس المدرسي البحت (الأنصاري، 1996). ولما فشلت هذه المحاولات المنفردة، راح العقل العربي الإسلامي يغط في سبات عميق، يحلم خلاله بأمجاد الماضي، ويقيس الخلف على السلف، ويطمئن أصحابه المسلمين العرب بأنهم أفضل خلق الله وأكثرهم علما بحقائق الدين والدنيا. وفي نفس الوقت تقريباً تمكن العقل الأوروبي من التحرر من القياس المدرسي الذي كان عبدا له في العصور الوسطى، القياس على متون أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، فانطلق نحو النهضة، وما كان لينطلق لو لم يحرر نفسه من القياس الذي كان يكبله، في حين أن ابن خلدون وابن حزم وابن رشد ظلوا بلا خلف ولم ينجبوا لا نهضة ولا علما في العالم العربي الإسلامي. وفي غزوة نابليون لمصر عام 1798، استيقظ العرب من أحلام عظمتهم وأمجاد ماضيهم ليكتشفوا فجأة أن الزمان من حولهم تحرك بينما ظل واقفا في ديارهم، وأنهم في الواقع ليسوا أفضل خلق الله ولا أشدهم بأساً ولا أكثرهم علماً، بل هم أصبحوا فريسة لا حول لها ولا حيلة (زيادة، 1987). ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة، لا يزال الشغل الشاغل للعقل العربي الإسلامي هو الإجابة على السؤال: لماذا تقدم الغرب وتخلف المسلمون؟ وبدل أن يدرك العرب أن الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن العقل العربي الإسلامي ظل عبداً للقياس بينما تحرر العقل الغربي منه، فإنه لمن المفارقات العجيبة أن العقل العربي الإسلامي أصبح معتاداً على القياس إلى حد أن كل الإجابات التي طرحت كانت ولا تزال إجابات قياسية، وكل المحاولات لإيجاد حلول للخروج من وضعية الضعف والتخلف كانت ولا تزال مبنية بشكل أساسي على المنهج القياسي الذي يقتل الإبداع ويمنع استقلالية الفكر، وما حال العرب في ذلك إلا كحال أبي النواس الذي قال "وداوني بالتي كانت هي الداء!"
يمكن تلخيص الإجابات التي تم طرحها، على الرغم من كثرتها، في ثلاثة اتجاهات رئيسية: الاتجاه الأول يرى العلة في الابتعاد عن الدين والحل في العودة إليه، عملاً بمقولة مالك بن أنس "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها." والاتجاه الثاني يرى العلة في هيمنة الماضي على الحاضر، ويرى الحل في القطيعة الكاملة مع الماضي والاندماج الكلي في الغرب وفكره وحضارته. أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه توفيقي يحاول أن يوفق بين ما يمكن أن يتفق من الفكر الغربي مع التراث العربي الإسلامي (عماره، 1980).
وبإمعان النظر في هذه التيارات الثلاثة، نجد أنها متشابهة ؟ بل متطابقة ؟ في آلية التفكير، وهي آلية القياس. فكلها تنطلق من "قياس الشاهد على الغائب"، وتسعى للحكم على "ما هو هنا" من خلال إسناده إلى "ما هو هناك". فالاتجاه الأول يجهد في المقارنة بين مستجدات الحاضر وبين ثوابت الماضي، ويحكم على المتغير المستجد بالقبول أو الرفض بناءاً على تماثله المفترض مع متغير سابق حـَكـَم عليه هذا الإمام أو ذاك، أو ورد فيه نص في القرآن أو السنة، أو حاز على الإجماع في أيام السلف الصالح (الأنصاري، 1996). فالحكم هنا لا يتم من خلال تحليل وفهم المستجد في سياق المستجدات الأخرى من حوله، بل بتسطيحه واختزال محتواه وقطعه من سياقه الموضوعي، ومن ثم قياسه الظاهري على ما يمكن الافتراض بأنه مشابه له في سياق كان في زمان آخر وواقع آخر (مثال على ذلك، تحريم الفائدة البنكية بحكم التشابه المفترض بينها وبين الربا).
وإذا كان الاتجاه الأول يقيس الحاضر على الغائب زماناً، فإن الاتجاه الثاني يقيس الحاضر على الغائب مكاناً، فهذا الاتجاه يحكم على المتغير المستجد في واقعنا العربي بناءاً على تماثله المفترض مع متغير في واقع آخر، هناك، في الغرب. والحكم في هذه الحالة كذلك لا يتم من خلال تحليل وفهم المستجد في سياق المستجدات الأخرى من حوله، بل بتسطيحه واختزاله وقطعه من سياقه الموضوعي، ومن ثم قياسه الظاهري على ما يمكن الافتراض بأنه يماثله في مكان آخر، أي في سياق ثقافي واجتماعي وفكري آخر (أمثلة على ذلك، تبني الديمقراطية لأنها أدت إلى التقدم في الغرب، وقبول النظريات الغربية في العلوم الاجتماعية لأنها أثبتت نجاعتها في فهم المجتمعات الغربية). أما الاتجاه التوفيقي فهو يحاول أن يمسك العصا من وسطها في محاولته التوفيق بين ما هو وافد علينا من الغرب وما نوفد أنفسنا إليه من التراث العربي الإسلامي، وهو في ذلك قياسي كالاتجاهين الآخرين، بل هو أكثر منهما اختزالاً وتسطيحاً لمستجدات الواقع وقطعها عن سياقها الثقافي والاجتماعي والفكري في محاولته التوفيق بين مفاهيم الغرب وثوابت التراث العربي الإسلامي (الحمد، 1991) (مثال على ذلك، قبول حقوق الإنسان في صيغتها الغربية لا لسبب إلا لأنها مبنية على مبدأ يـُفترض وجود مثيل مطابق له في الإسلام، استناداً إلى قول الخليفة عمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟").
وهكذا نرى أن العقل العربي الإسلامي على الرغم من إدراكه لأزمة عجزه ومحاولاته الدءوبة للخروج من تخلفه، فإنه لا يزال في مجمله عقلاً قياسياً مقارناً يستمد "الحقيقة" مما هو غائب عنه زماناً أو مكاناً، وليس عقلاً تحليلياً استنباطياً يستمد "الحقيقة" من فهم المتغيرات المستجدة بذاتها وفي سياقها الفعلي (الجابري، 1985). وهو كذلك ؟ في رأيي- عقل تقديسي، يقدس النص ويضفي عليه بعداً ميتافيزيقياً خارج الزمان والمكان فيخرج "حقائقه" من دائرة الفكر والنقد والتغيير، وهو تقديسي ليس فقط في تناوله للقرآن والسنة، بل كذلك في تناوله لنصوص السلف من أئمة المذاهب والمناهج، إن كان هؤلاء من أئمة العرب كالشافعي ومالك والأشعري والغزالي، أو من أئمة الغرب كسبنسر ودوركهايم وفرويد وليفي شتراوس. ولا يمارس هذا التقديس في الجوامع ودور الشريعة فحسب، بل وفي الجامعات ودوائر العلوم الاجتماعية والإنسانية على حد سواء. ولهذا فإن العقل العربي الإسلامي يفتقد إلى الإبداع والفاعلية من حيث وضع أسس مستقلة لدراسة الإنسان والمجتمع، وهو من ثم غير قادر لا على أن يكون بديلاً للعقل الأوروبي في هذا المجال، ولا على أن يطرح البدائل لهذا العقل.
ونحن لا ننكر أن القرن العشرين شهد محاولات جدية رائدة لنقد المنهج القياسي في سبيل تحرير العقل العربي الإسلامي منه، إلا أن هذه المحاولات ارتطمت كلها بصخرة التقليد ومؤسساته، فأُجهـِض البعض منها وهـُمِّـش البعض الآخر، وأما القليل الذي تبقى من هذه المحاولات فهو عاجز عن أن يذيب جمود العقل العربي ويحرره من القيود التي اعتاد عليها إلى أن أصبحت هذه القيود جوهره ومضمونه (الأنصاري، 1980). فطه حسين الذي حاول إعادة النظر في الشعر الجاهلي من خلال التفكير التحليلي المستقل، انتهى به الأمر إلى الاعتذار والتوبة والعودة إلى أحضان الاجترار الذهني التقليدي، وكذا كان مصير علي عبد الرازق الذي حاول التشريع لعقل سياسي جديد ينبع من الواقع العربي المعاصر. أما صادق جلال العظم فلوحق وحوكم وسُجن إلى أن اختار توخي الحذر وإشغال فكره في قضايا فرعية، وأما أدونيس فآثر الصمت إلى أن لفه النسيان، وأما إدوارد سعيد فقـَبـِل أن يظل محسوباً على الغرب ولم يحاول اختراق العقل العربي التقليدي الذي رفض الاستفادة من فكره، وأما محمد عابد الجابري (وأمثاله من المعاصرين) فلا يزال يدور حول حصن العقل العربي التقليدي المنيع، يرمي سهامه إلى داخل الحصن حيناً وحممه حيناً آخر، لكنه أبعد ما يكون عن أن يدك أسوار الحصن ويجتاحه ويحرر من وما بداخله.
كيف؟ وإلى أين؟
ليس من السهل أن نحرر العقل العربي الإسلامي مما اعتاد عليه لأكثر من ألف عام، وليس من السهل على عدد قليل من النقاد والمفكرين العرب أن يوقظوا هذا العقل من سبات لم تستطع أن توقظه منه الحملات الصليبية، وغزوة نابليون بونابرت، واستعمار أوروبا للعالم العربي، واغتصاب الصهيونية لفلسطين، وتهديد اسرائيل المتواصل للعالم العربي والإسلامي كله، وسيطرة أمريكا الفعلية على مصير هذه الأمة ومقدراتها. فالقياس كالمخدر الذي يُدمن عليه العقل الكسول، ذلك العقل الذي يجد المتعة بالسكينة ويريد من هذه المتعة أكثرها وأسهلها منالا. ولكن إذا كنا حقيقة نريد أن نحرر أنفسنا من هيمنة العقل الغربي، فلا بد لنا من أن نتعامل بوعي وجدية مع مصدر عجزنا لكي نتمكن من التصدي لهيمنة الغرب علينا ومن ثم ننطلق نحو تخليص عقول أجيالنا المقبلة من كل ما يكرس فيها الفكر الاستعلائي الضيق للحداثة الغربية.
كلنا نعرف من تجاربنا الحياتية أن المحروم لا يفكر بالمساواة المطلقة بقدر ما يفكر بالحصول على ما هو محروم منه، وأن المظلوم لا يفكر بالعدالة المطلقة بقدر ما يفكر بالاستقواء على ظالمه للتخلص من ظلمه له، فالحرمان والظلم يحدان من أفق التفكير ويُغـَـلـبان المصلحة الآنية على المصلحة البعيدة المدى. ولذلك فإنه من الطبيعي أن يفكر الإنسان العربي بمنهج عربي إسلامي لدراسة الإنسان والإنسانية أكثر مما يفكر بالإنسان والإنسانية ، ومن الطبيعي أن يعتقد المفكر العربي أن التخلص من سيطرة الفكر الغربي على علم الإنسان والمجتمع لا يتم إلا بإيجاد مدخل عربي إسلامي لدراسة الإنسان والمجتمع. ولكني مقتنع تماماً أن ما نحتاجه نحن وأجيالنا القادمة هو ليس عقلاً عربياً إسلامياً متميزاً، فالتميز يؤدي إلى التحيز، والتحيز يؤدي إلى التزمت، والتزمت يؤدي إلى الانغلاق، والعقل المتزمت المنغلق ينزع حتماً إلى فرض نفسه على الآخر وإلى فرض نفسه على الذات، وكلاهما خاطئ لأن الخطأ يكمن في مبدأ الفرض وليس في هوية من يقع الفرض عليه.
ما يميز الإنسان عن غيره من الموجودات على هذه الأرض هو أنه كائن مفكر مدرك يتوسط العقل دوماً وحتماً بينه وبين ما عداه من الموجودات. ووجود الإنسان على هذه الأرض وجود واحد لا يتجزأ، وأية محاولة لتجزئة هذا الوجود هي عبث بمصير الإنسانية كلها في نهاية المطاف (وهذه هي الخطيئة الكبرى للسياسة والسياسيين). ولذلك فليس العلم علماً وليست المعرفة معرفة إلا إذا كانا شموليين إنسانيين بالمنطلق والمشاركة والغاية، والحديث عن علم غربي وعلم شرقي، علم عربي وعلم أعجمي، علم إسلامي وعلم مسيحي، هو من قبيل التناقض الداخلي على مستوى التعريفات والمفاهيم. وكذلك الأمر بالنسبة للحديث عن المعرفة بكل أشكالها، فأية تجزئة لها تتناقض مع أسس وجودها. ومن هنا فإن أخطر ما في الحداثة الغربية هو أنها اختطفت العلم والمعرفة الإنسانيين واغتصبتهما، واحتكرتهما، وشكلتهما على شاكلتها الغربية النخبوية الاستعلائية ثم فرضتهما على نفسها وعلى الوجود البشري كله. والحداثة بهذا المعنى لم تعـتـَد ِعلى العقل العربي الإسلامي وحده، بل على العقل الإنساني كله، وعليه فليس من الممكن ولا من السليم أن نفصل بين أزمة العقل العربي الإسلامي وأزمة العقل الإنساني، أو بين مصير الإنسان العربي ومصير الإنسانية بأكملها. ومن هنا فإنني أرى أن التحدي الأكبر الذي نواجهه نحن العرب في هذا العصر هو تمكين العقل العربي الإسلامي من المساهمة الفعلية في فك أسر العلم والمعرفة الإنسانية من قبضة العقل الغربي الحداثي، ومن ثم المساهمة الفعلية في مشروع "أنسنة" العلم و"علمنة" الإنسانية، لكي يصبح العلم علماً والمعرفة معرفة بالمعنى الذي يتلاءم مع مصلحة ومتطلبات الوجود الإنساني على هذه الأرض.
لقد قال العديد من المفكرين عبر التاريخ أن طبيعة الوجود الإنساني تتناقض مع الطبيعة الاجتماعية للإنسان (على الرغم من ضرورة إحداهما للأخرى)، فالأولى تتطلب وحدته الكلية بينما تعمل الثانية على تجزيء هذه الوحدة وشرذمتها. وعلى الرغم من وحدة مصير الإنسان على الأرض فإن الإنسان ينزع بحكم انتماءاته الاجتماعية إلى تفضيل الانتماء الضيق على الانتماء الواسع، وكلما ضاق إطار الانتماء كلما احتل ذلك الإطار أهمية أكبر في حياة الإنسان وفكره وممارساته. وهذا بالطبع ينطبق على الإنسان العربي الذي يستاء من التعدي على عروبته أكثر مما يستاء من التعدي على إنسانيته، والذي يصعب عليه أن يفكر بمصير الإنسانية وهو غير قادر على التحكم بمصيره العربي المحلي. ولذا فإن مساهمة العقل العربي في مشروع "أنسنة" العلم و"علمنة" الإنسانية - وهي الوصفة الوحيدة للخروج من أزمة هذا العصر- تستلزم تبني منطلقات جديدة في الفكر والانتماء تتيح لهذا العقل الخروج من محدودية الثقافة والانطلاق نحو آفاق إنسانية عالمية للعلم والمعرفة.
وليست هذه دعـوة معادية للثقافة أو مقللة من شأنها، كما يبدو لأول وهلة، بل هي في حقيقة الأمر دعـوة تنطلق من الاقتـناع اللامشروط بأن الثقافة هي جوهر وجودنا الإنساني. إلا أننا (وعلى الرغم من هذا الاقتناع) يجب أن نعترف بأن ثقافة الشعوب والأمم، شأنها شأن الهوية، هي في صميمها وبحكم طبيعتها مبنية على التفرد والمحدودية وتفضيل الذات على الغير. ولذا فإن تحرير الفكر الإنساني من هيمنة الشعوب والأمم، غربية كانت أم شرقية، لا يتم إلا بالتغلب على محدودية الدوائر الضيقة للثقافة والانطلاق إلى الدائرة الأوسع والأكبر، دائرة الجنس البشري، لتصبح الثقافة الإنسانية بكليتها مصدراً للفكر الإنساني ومرجعاً له.
قائمة المراجع
مراجع بالعربية:
الأنصاري، محمد جابر
(1980) تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي: 1930-1970. الكويت، عالم المعرفة.
(1996) الفكر العربي وصراع الأضداد. بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
أبو زيد، نصر حامد
(1992) الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية. القاهرة، سينا للنشر.
الجابري، محمد عابد
(1985) تكوين العقل العربي. بيروت، دار الطليعة.
الحمد، تركي
(1991) دراسات إيديولوجية في الحالة العربية. بيروت، دار الطليعة.
الخولي، يمنى طريف
(2000) فلسفة العلم في القرن العشرين: الأصول-الحصاد-الآفاق المستقبلية. الكويت، عالم المعرفة.
الدمشقي، الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي
(1992) تفسير القرآن العظيم. بيروت دار المعرفة.
رسل، برنارد
(1983) حكمة الغرب: عرض تاريخي للفلسفة الغربية في إطارها الاجتماعي والسياسي (ترجمة فؤاد زكريا). الكويت، عالم المعرفة.
زيادة، معن
(1987). معالم على طريق تحديث الفكر العربي. الكويت، عالم المعرفة.
الشكعة، مصطفى
(1983) الأئمة الأربعة. بيروت، دار الكتاب اللبناني.
نافعة، حسن وكليفورد بوزورث
(1978) تراث الإسلام (الجزء الثاني). الكويت، عالم المعرفة.
النمر، عبد المنعم
(1986) الاجتهاد. القاهرة، دار الشرق.
العظمة، عزيز
(1996). دنيا الدين في حاضر العرب. بيروت، دار الطليعة.
مراجع بالإنجليزية:
Adorno, Theodor (1977) Aesthetics and Politics. London: New Left Books.
Berman, Marshall (1983) All That is Solid Melts into Air. London: Verso.
Bertens, Hans (1986) ؟The postmodern weltanschauung and its relation with modernism: An introductory survey.؟ In Douwe Fokkema & Hans Bertens (Eds.) Approaching Postmodernism (pp.9-53). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Boyne, Roy & Rattansi, Ali (1990) ؟The theory and politics of postmodernism: By way of an introduction.؟ In Roy Boyne & Ali Rattansi (Eds.) Postmodernism and Society (pp.1-45). Basingstoke: Macmillan.
Callinicos, Alex (1990) ؟Reactionary postmodernism?؟ In Roy Boyne & Ali Rattansi (Eds.) Postmodernism and Society (pp.97-118). Basingstoke: Macmillan.
Clifford, James (1986) ؟Introduction: Partial truths.؟ In James Clifford & George E. Marcus (Eds.) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (pp.1-26). Berkley/Los Angeles/London: University of California Press.
Crook, Stephen (1990) ؟The end of radical social theory? Radicalism, modernism and postmodernism.؟ In Roy Boyne & Ali Rattansi (Eds.) Postmodernism and Society (pp.46-75). Basingstoke: Macmillan.
Fox, Richard G. (1991) ؟Introduction: Working in the present.؟ In Richard G. Fox (Ed.) Recapturing Anthropology: Working in the Present (pp.1-16). Santa Fe: School of American Research Press.
Frankel, Boris (1990) ؟The cultural contradictions of postmodernism.؟ In Andrew Milner, Philip Thomson & Chris Worth (Eds.) Postmodern Conditions (pp.95-112). New York/ Oxford/Munich: Berg.
Habermas, Jørgen (1987) The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge: Polity Press.
Heller, Agnes (1990) ؟Existentialism, alienation, postmodernism: Cultural movements as vehicles of change in the patterns of everyday life.؟ In Andrew Milner, Philip Thomson & Chris Worth (Eds.) Postmodern Conditions (pp.1-13). New York/Oxford/Munich: Berg.
Huyssen, Andreas (1986) After the Great Divide: Modernism, Mass Culture and Postmodernism. London: Macmillan.
Keller, Evelyn Fox (1985) Reflections on Gender and Science. New Haven: Yale University Press.
Lunn, Eugene (1985) Marxism and Modernism. London: Verso.
Lyotard, Jean Francois (1984) The Post-modern Condition: A Report on Knowledge (Geoff Bennington & Brian Massumi, trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
Margolis, Joseph (1986) Pragmatism without Foundations. New York/Oxford: Blackwell.
Pool, Robert (1991) ؟Postmodern ethnography.؟ In Critique of Anthropology, 11, 309-331.
Roberts, David (1990) ؟Marte/Sade, or the birth of postmodernism from the spirit of the avant-garde.؟ In Andrew Milner, Philip Thomson & Chris Worth (Eds.) Postmodern Conditions (pp.39-59). New York/Oxford/Munich: Berg.
Roberts, John (1990) Postmodernism, Politics and Art. Manchester/New York: Manchester University Press.
Rorty, Richard (1979) Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press.
Trouillot, Michel-Rolph (1991) ؟Anthropology and the savage slot: The poetics and politics of otherness.؟ In Richard G. Fox (Ed.) Recapturing Anthropology: Working in the Present (pp.17-44). Santa Fe: School of American Research Press.
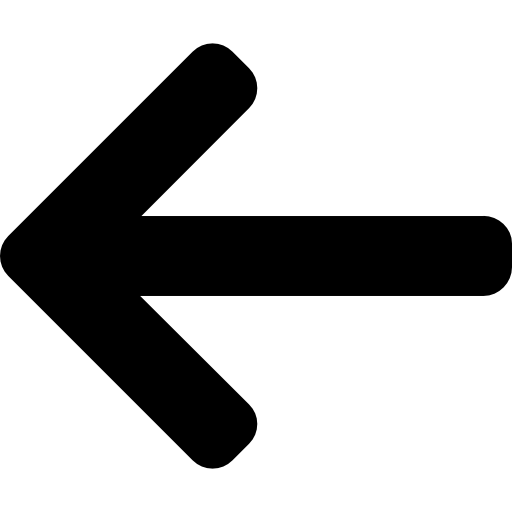



شارك بتعليقك