حول مجموعة "ما قاله الميت" للقاص الراحل جمال يونس عطاطره - عشرون قصة عن الموت والأرض والمرأة
بقلم: علي الخليلي
عن (الأيام) الفلسطينية
في العام 1994 عاد القاص جمال يونس من غربته الطويلة إلى الوطن على الأكتاف المهتزة لما كنا نسميه "اتفاق أوسلو". تلك عودة مجتزأة، وهذا وطن مجتزأ. لا بأس.
كان حزينا إلى حد تماهيه مع الأجزاء المبعثرة، فما يكاد يراه أحد حتى يرى التمزق الشامل فيه. هل عاش غريبا في وطنه أيضا؟ غربة الوطن أقسى من غربة المنفى بمراحل لا قياس لها إلا الموت. في العام 1999، بعد خمس سنوات من عودته، أو من غربته الأقسى، مات جمال يونس. رحل فجأة. إلى أين؟ سؤال قصصي بحت. كأنه يكابد في الخفاء من أجل صياغة إحدى قصصه القصيرة، ليعود بها بعد حين، أو تعود به مجددا، على طريقة ما ائتلفا عليه في المكابدة؟ وقد عاد بالفعل، ولكن على شكل مجموعة قصصية كاملة كان قد ترك مخطوطتها لدى مركز أوغاريت للنشر والترجمة في رام الله، لتصدر بعد وفاته بأيام قليلة. وكان من اللافت للنظر أن يختار لها عنوان "ما قاله الميت". هل كان يعدّ لموته سلفا في هذه المجموعة، فإذا صدرت بعد موته هذا، بقي حيا معنا يقص علينا قصصه بحضور فني (روحي) أقوى من حضور الجسد؟
في الذكرى السنوية الثامنة لرحيله، أعود إلى هذه القصص. أقرأها بهدوء وحزن، وبعمق يفوق في معانيه ما سبق لي من معاني قراءة ماضية لها. ماذا يقول الميت؟ ليس ميتا. ثمة هو الآن جمال يونس نفسه، يحدثني عن نفسه وجها لوجه. كيف لي أن أنقل مثل هذا الحديث على الورق؟ تتحول الكآبة على شفتي القاص الموغل في الظلال، إلى ما يشبه ابتسامة دافئة. يقول لي: "لا تنقل شيئا". ويقول بما يقارب العتاب: هل تحاول أن تكتشف في قصصي ما أنتم فيه الآن، من نكبة مكررة؟ كدت أن أقول له إن الشاعر الكبير محمود درويش كتب أيضا قصيدته المطولة "جدارية" وأصدرها في كتاب منفصل، وحيدة لا سواها في الكتاب. جدارية القبر؟ رخامة ضخمة منقوشة بالشعر المأتمي على امتداد الوطن المجزّأ المجتزأ الممزق عبر دهليز "اتفاق أوسلو" الميت ذاته. شاهدة الموت؟
تشتمل المجموعة على عشرين قصة قصيرة، كلها تقريبا تتحدث عن الموت بأشكال وأنماط مختلفة، على امتداد ثمانٍ وتسعين صفحة من القطع المتوسط. ومع الفراغ من قراءة هذه القصص، يصبح العنوان الرئيس الذي جعله المؤلف لها "ما قاله الميت"، حين هو في آن، عنوان إحداها، عاديا وغير مثير طالما أن الموت رغم تغير عناوين بقية القصص، مهيمن ومبثوث فيها جميعها. وقد تنبه الناقد وليد أبو بكر في تقديمه لهذه المجموعة، لهذا البعد التراجيدي فيها، حيث "أن نسبة عالية من هذه القصص لا تخلو من الموت طبيعيا كان أو قتلا أو انتحارا أو موتا طبيعيا، مما يوحي بأن هاجس الموت كان حاضرا في ذهن الكاتب وكأنه كان يستشعره إلى الحد الذي وصف فيه جنازته في (ما قاله الميت)، ربما كما حدثت بعد ذلك..". أما الروائي عزت الغزاوي الذي رحل بعده بسنة واحدة، فقد كتب على الغلاف الأخير للمجموعة ذاتها، ما يلامس شغاف الرثاء الحار للمؤلف أكثر مما هو نقد أو عرض مكثف للقصص: "لم نكن جاهزين للوداع كما كنت جاهزا للموت.. ولم نعرف تماما ماذا أفادتك صحراء الجزيرة التي جئت منها بعد غياب.. جئت تحمل خيبة المسافر الذي يخاف اللوم. فما صارت الغربة وطنا. وبعودتك لم يكن الوطن محطة تأمل لأن التنقل بين الحواجز كان أقسى من البحث عن هوية ضائعة وسط وجوه شديدة الصرامة..".
والواقع الذي أثقل على هذا الرثاء حتى كاد أن يتوارى (الواقع نفسه) خلفه في الحزن والذهول، أن الوطن كان ولم يزل "محطة تأمل" وهو يوغل في النكبة مرحلة إثر أخرى. وإلا، كيف أمكن لهذه القصص أن تكون؟ وكيف أمكن لهذه التراجيديا أن تتوالى في السرد؟
وإلى ذلك، فإن الأهم في وجهة نظري، من الموت التراجيدي المسيطر والملهِم في هذه القصص، هي "الأرض التراجيدية" الأكثر سيطرة والأعمق إلهاما فيها. أي أن الوطن الفلسطيني المنهوب بالاستيطان اليهودي، والممنوع عن أهله الأصليين ومواطنيه الحقيقيين، بالنار والدم، هو الحاضر في كل حال. ومن البداهة في هذا "الواقع" أنه حضور النار والدم. حضور الموت، بقدر ما هو، وعلى الفور، حضور الحياة. أليست الكتابة في هذا المعنى حضور الحياة؟ أليست القصص التي تجيء إلينا على لسان الميت، هي قبل هذا اللسان وبعده، لسان الحياة؟ أليست هي في السياق كله حياة الأرض وأرض الحياة؟
أعني أن الراحل جمال يونس عطاطره كان في قصصه "ما قاله الميت" متأملا بالحياة وبالوطن المفتت الذي عاد إليه، إلى حد الاستغراق التام بهذا التأمل، وصولا به إلى الموت. ليس الموت العادي، ولو أنه على الفراش. ولمثل هذا الوصول الإنساني، لم يكن بالصدفة أن يهدي المؤلف نفسه قصصه إلى "نكهة المتشكل في الإنسان وعيا وحضورا". دون أن ننسى الجزء الثاني أو الأول على الأصح، من إهدائه، وهو "إلى كل امرأة تعرف كيف تتعالى على رحاب الدهشة وتأبى أن تكون مجرد جسد محكوم بأعراف القبائل الهمجية"، ذلك أن جمال يونس في كل هذه القصص، كان قد رفع المرأة في دفاعه (دفاع المستميت) عن حقوقها، إلى مستوى الدفاع عن الحياة ذاتها في مواجهة الموت والعتمة والاحتلال الاستيطاني.
في قصة "ما قاله الميت" نقرأ عن الموت. أو عن الميت الذي هو فلاح فلسطيني بسيط وفقير يضطر للعمل في مستوطنة يهودية "يسميها مستعمرة" مقامة أصلا على أجزاء من قريته المحتلة. يعمل ويكد، حتى يهده الشقاء الطويل والذل والحزن والغضب المكبوت، فيسقط ميتا وهو لا يزال في الثلاثين أو الأربعين من عمره. يرفع رأسه، هذا الميت الذي لن تكثرث به سوى زوجته وبعض أهل قريته، من تابوته المتواضع ويقص علينا قصته القصيرة جدا. يقول: "..ما نغص عليّ هو قرب مقبرة قريتنا الشرقية من المستعمرة التي شربت عرقي وأتت على زهرة شبابي..". ويكاد أن يحدثنا عن زوجته الطيبة خيرية التي لا يتذكر متى آخر مرة رآها فيها تلبس له غير ذلك الثوب القديم البالي، وهي تعد له كل يوم إفطاره المعتاد زيتا وزعتر وزيتونا ورغيف طابون..، وأن يعقد أمامنا مقارنة بينها وبين المستوطِنة إستر زوجة المستوطن يوخي الذي كان يعمل عنده. ومع أنه يعقد هذه المقارنة المستحيلة بالفعل، في السرد الذي يطرحه لنا نحن فحسب، فإنه بالمقابل، يؤكد لزوجته وحدها أنه سيروي لها ما يظن أنه الحلم في اليوم الثاني. غير أنه يموت، لتبقى القصة لنا، قصة الموت بقدر ما هي قصة الأرض المغتصبة والمرأة الفلسطينية الكادحة.
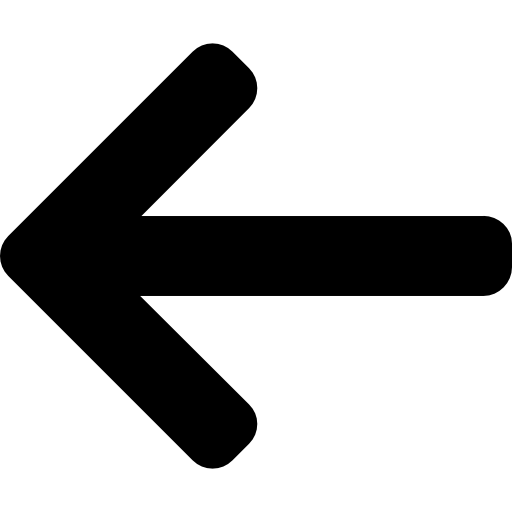



شارك بتعليقك